 |
| د. بسام أبو عليان قسم علم الاجتماع - جامعة الأقصى |
مدخل
إلى الخدمة الاجتماعية[1]
هل الخدمة الاجتماعية علم
أم فن؟
تفاوتت
الإجابة على هذا السؤال، وقد انقسمت الآراء إلى ثلاث اتجاهات:
· الأول:
يرى الخدمة الاجتماعية (علم).
· الاتجاه
الثاني: يرى الخدمة الاجتماعية (فن).
· الاتجاه
الثالث: يرى الخدمة الاجتماعية تجمع بين (العلم والفن).
أميل
إلى الاتجاه الثالث، الذي يعتبر الخدمة الاجتماعية (علم، وفن)؛ لأنها ليست علمًا
مستقلًا، ولا تعد فنًا صرفًا، بل تعتمد على مجموعة مهارات مهنية، وقدرات ذاتية
للأخصائي الاجتماعي، وقواعد علمية ومعرفية.
التطور التاريخي لمهنة الخدمة
الاجتماعية:
حدد
"عبد الفتاح عثمان" أهم الأحداث التي ساهمت في تطور مهنة الخدمة الاجتماعية،
وقد جعلها في الآتي:
1.
الثورة
الصناعية:
رغم الإنجاز الكبير الذي حققته الثورة الصناعية للبشرية، وانتقالها من عصر إلى عصر، إلا أنه رافقها مشكلات اجتماعية واقتصادية كثيرة لم تكن تعرفها المجتمعات الغربية من قبل، مثل: (هجرة الريف إلى الحضر، وعمالة الأطفال، وعدم التكيف الأسري، وارتفاع معدلات الطلاق، وإقامة العشوائيات السكنية... إلخ). فقد بينت تلك المشكلات مدى عجز الأنظمة الاجتماعية التقليدية في علاج مشكلات المجتمع، مما تطلب استحداث مهنة تسهم في حلها، هذه المهنة تمثلت في "الخدمة الاجتماعية".
2.
الحروب:
كل
حرب تخلِّف وراءها أعدادًا كبيرة من الضحايا، والأرامل، والأيتام، والمعاقين، والمشكلات
النفسية، والسلوكية، والاجتماعية، والاقتصادية. مما يعني زيادة نسب الفئات المهمشة
والفقيرة في المجتمع، التي هي بحاجة إلى التأهيل النفسي والاجتماعي؛ حتى تتمكن من
التكيف مع واقعها الاجتماعي الجديد. هذا الواقع تطلب وجود مهنة جديدة تسهم في
دراسة مشكلات وحاجات تلك الفئات، والعمل إشباعها، هذه المهنة هي: الخدمة
الاجتماعية.
3.
انتهاء
عصر الإقطاع:
أدت
هجرة الفلاحين المتزايدة من الريف إلى المدن، ـ بحثاً عن الرزق وتحسين مستواهم
المعيشي ـ، لارتفاع معدلات المشكلات الاجتماعية في المدن كالتسول، والسرقة،
والبغاء، وتعاطي المخدرات، وعمالة الأطفال، وتشكيل أحياء الفقراء. في وقت لم تكن
المدن مهيأة لاستقبال أعداد المهاجرين الكبيرة، مما ترك أثرًا سلبيًا على
المهاجرين والمدن معًا. على صعيد المهاجرين لم يستطيعوا التكيف مع بيئة المدينة
الغريبة عنهم في الطباع، والأخلاق، والعادات، والتقاليد، والتكنولوجيا، والعلاقات
الاجتماعية. وأثّرت سلبًا على المدينة إذ أصبحت تعاني من مشكلات، مثل: ضعف شبكة
العلاقات الاجتماعية، وزيادة معدلات التفكك الاجتماعي، وانتشار الجريمة، وتدني خدمات
الرعاية الاجتماعية، وإرهاق النظم الاجتماعية. هذا كله ساهم في ظهور مهنة الخدمة
الاجتماعية لتساعد في دعم العلاقات الاجتماعية، وتحقيق التكيف الاجتماعي لأفراد
المجتمع.
4.
فشل
التشريعات الغربية في مواجهة مشكلة الفقر:
لم
تستطع التشريعات الغربية مواجهة مشكلة الفقر المتفشية في المجتمع منذ صدور قانون
الفقر الإنجليزي سنة (1601م)، وما تبعه من تشريعات أخرى. هذا الفشل مرده: عدم قيام
تلك التشريعات على أسس علمية وقواعد منهجية، فقد كانت تحمِّل الفرد مسؤولية فقره، وتبرئ
أنظمة المجتمع من ذلك. بمعنى آخر كانت التشريعات الغربية تعالج مشكلة الفقر بشكل
سطحي، ولم تلامس الأسباب الحقيقية للمشكلة والعمل على تطويقها.
ميز
قانون الفقر الإنجليزي (1601م) بين ثلاث فئات من الفقراء، هي:
أ. الفقراء الأصحاء: قادرون على العمل، يلزمون
بالعمل في بيوت الإصلاح.
ب. الفقراء غير القادرين على العمل: كـ(المرضى،
والشيوخ، والمعاقين)، يودعون في ملاجئ خاصة بالعجزة. إن ثبت لأحدهم مكان يأوي إليه
تتم إعالته فيه؛ لأنه أقل تكلفة من الإعالة في الملجأ.
ج. الأيتام واللقطاء: هؤلاء قد تكون هَجَرتهم
أسرهم، أو أسرهم غير قادرة على إعالتهم. يمنحون لأي مواطن يرغب في إعالتهم ورعايتهم
دون مقابل.
مع
مرور الوقت، تحديدًا في القرن الثامن عشر لقي قانون الفقر معارضة شديدة من قبل
دافعي الضرائب، الذين كانت تدفع ضرائبهم لصالح الفقراء، حيث بلغت في الثلث الأخير
من القرن المذكور ستة أضعاف ما كانت عليه في بداية القرن. ترتب على ذلك زيادة
أعداد الفقراء الذين أصبحوا يشكلون عبئًا ثقيلًا على الدولة. الأمر الذي دفع
الدولة لتشكيل لجنة مهمتها مراجعة الأساليب التي اتبعت في تطبيق قانون الفقر، وقد استمرت
المراجعة مدة عامين. وأهم ما توصلت إليه اللجنة: "حوّل قانون الفقر الفئات
الفقيرة والمحتاجة إلى عالة على الدولة، بدلًا من تشجيعهم على العمل، والاعتماد
على أنفسهم".
توصيات اللجنة:
أ. إرسال الفقراء القادرين على العمل إلى
بيوت التشغيل.
ب. منح المساعدات لمستحقيها من الشيوخ،
والأرامل، والفقراء، والمحتاجين.
ج. تنسيق المساعدات؛ لمنع تكرارها.
د. تكوين مجلس أعلى للرقابة.
بناءً
على تلك التوصيات صدر قانون آخر للفقر سنة (1834م)، نص على: "إيداع جميع
الفئات الفقيرة، ـ كبارًا وصغارًا ـ، والمرضى، وذوي العاهات في مؤسسة واحدة".
فأدى تطبيقه إلى تقليص أعداد الفقراء إلى الثلث. لكن، مما يؤخذ على هذا القانون: أنه
جعل مؤسسات الإيداع أقرب إلى السجن منه إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
في
المحصلة النهائية: قانون الفقر الثاني لم يكن أحسن حالًا من قانون الفقر الأول، كلاهما
فشلا في علاج مشكلة الفقر، هذا الفشل أدى إلى تحرك مثقفي المجتمع، الذين انتقدوا
سياسة مؤسسات الإيداع، في إنتاجهم الأدبي والفكري والإعلامي، مما دفع الدولة إلى تشكيل
لجنة جديدة برئاسة أحد أعضاء البرلمان، للتعرف على أسباب الفقر، وتقديم مقترحات لتحسين
الوضع برمته. فقد بينت النتائج: أن الأحياء الفقيرة تعاني من سوء التغذية، وسوء
الصرف الصحي، وانتشار الأمراض. وقدم التقرير إلى المناقشة في البرلمان. بناءً عليه
اتخذت عدة إجراءات إصلاحية على الصعيدين: الصحي، والاجتماعي. على الصعيد الصحي:
وضعت برامج لمكافحة الأمراض، وبرامج للوقاية الصحية كالتطعيم، والتثقيف الصحي،
وتحسين وضع المساكن. أما على الصعيد الاجتماعي: وضعت برنامج لتوزيع المساعدات على
الفقراء تحت إشراف مركزي، وبناء مساكن شعبية للفقراء، وإنشاء مدارس للتعليم.
5.
الاختراعات
العلمية الحديثة:
ساهمت
الاختراعات العلمية الحديثة في تفسير سلوك الإنسان، ومعرفة الدوافع التي تكمن
وراءه، وكيفية مواجهة أنماط السلوك الشاذة.
6.
الأبحاث
الاجتماعية:
تأسست
حركة البحث الاجتماعي سنة (1886م)، قادها أحد رواد المسح الاجتماعي "شارلز
بوث"، الذي استعان بفريق من الباحثين في الدراسة، التي هدفت للتعرف على جوانب
متعددة من حياة أصحاب الحرف، مثل: ظروف العمل، وساعات العمل، والأجور. تبين له أن
ثلث سكان لندن يعيشون تحت خط الفقر، وأن تدني الأجور ساهم في ارتفاع نسبة الفقر في
المجتمع.
بشكل
عام، ساهمت الأبحاث الاجتماعية في إزاحة الستار عن الحاجة الماسة إلى التعمق في
دراسة سلوك الإنسان، وتفسير المشكلات الاجتماعية، حيث أن المشكلات الاجتماعية إن
كانت تتشابه في المظاهر، إلا أنها تختلف في الأسباب.
7.
جمعيات
تنظيم الإحسان والمحلات الاجتماعية:
تعتبر
جمعيات تنظيم الإحسان، والمحلات الاجتماعية، والمدرس الزائر، والممرض الزائر،
وسيدات الإحسان كلها اتجاهات مهدت لظهور مهنة الخدمة الاجتماعية. من أبرز حركات
الإصلاح الاجتماعي:
أ. حركة تنظيم الإحسان:
قامت
حركة تنظيم الإحسان على فلسفة: "الفقير القادر هو المسؤول عن فقره،
والمساعدات التي تقدم للفقراء تفسد أخلاقهم، وتجعلهم اتكاليين". هذا القول يعني
تبرئة الدولة من مسؤولياتها تجاه الفقراء.
قسمت
حركة تنظيم الإحسان لندن لمناطق صغيرة، يعمل في كل منطقة فريق من المتطوعين. من
أبرز مهامه: دراسة حالات المحتاجين، والإشراف على توزيع المساعدات، وتوجيه متلقي
المساعدة إلى كيفية التصرف فيها.
ب.المحلات الاجتماعية:
أسس
المحلات الاجتماعية سنة (1884م) قادة الإصلاح الاجتماعي، الذين كانوا يدرسون في
جامعة أكسفورد، وقد استخدمت أساليب جديدة في حل مشكلات (الفقر، والجهل، والأمية)،
غير الأساليب التقليدية التي كانت تتبع من قبل، وهي: الإقامة بين سكان الأحياء
الفقيرة، وجندت عددًا كبيرًا من طلبة الجامعات في لندن للتطوع في تلك الأحياء. وقد
استطاعت المحلات الاجتماعية تأسيس مركزًا جامعيًا باسم "توبيني"، له
ثلاثة أهداف رئيسية، هي:
v تعليم الفقراء، وتحسين مستواهم الثقافي.
v تزويد طلبة الجامعات بالمعلومات اللازمة
عن الفقراء وأحوالهم.
v استثارة الرأي العام الإنجليزي
بالمشكلات الصحية والاجتماعية.
تطور الخدمة الاجتماعية في
دول العالم الثالث:
أشرقت شمس الخدمة الاجتماعية في دول
العالم الثالث في شكلها الحديث في ثلاثينات القرن العشرين، بعد أن انتشرت كتابات
الخدمة الاجتماعية الغربية في العالم. فقد بيَّن التراث العلمي أن مدارس الخدمة
الاجتماعية الأمريكية ومؤسسات الأمم المتحدة ساهمت في ظهور الخدمة الاجتماعية في
دول العالم الثالث، حيث بدأت جهود الأمم المتحدة في العقدين الخامس والسادس من القرن
العشرين عبر تنظيم دورات تدريبية حول الممارسة المهنية، من أمثلة ذلك: اعتمدت
باكستان على خبراء الأمم المتحدة في الخمسينات لوضع سياسة الرعاية الاجتماعية
هناك، وفي الهند أقيمت أول مدرسة للخدمة الاجتماعية سنة (1946م) بواسطة المساعدات
الحكومية الأمريكية التي قدمت خصيصًا لهذا الغرض، وفي أندونيسيا أقيمت أول مدرسة
للخدمة الاجتماعية سنة (1957م) بإشراف الأمم المتحدة، وفي إيران أقيمت أول مدرسة
للخدمة الاجتماعية سنة (1958م)، وفي أوغندا افتتح أول قسم للخدمة الاجتماعية في
جامعة ماكريري سنة (1960م) بدعم مالي وفني من اليونيسيف.
على
الصعيد العربي: في السودان تبنت جامعة الخرطوم فكرة إنشاء برنامج لتعليم الخدمة
الاجتماعية بالتعاون مع الجامعات والحكومة البريطانية، وفي الأردن لعبت اليونيسيف
دورًا في تدريب موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية على مهارات الممارسة المهنية، ثم
افتتاح قسم الخدمة الاجتماعية في الجامعات الأردنية، وفي مصر أقيمت أول مدرسة
للخدمة الاجتماعية سنة (1935م) للجالية اليونانية، وسنة (1937م) أقيمت مدرسة
للخدمة الاجتماعية في القاهرة، وسنة (1946م) افتتح معهد الخدمة الاجتماعية للفتيات
حوِّل فيما بعد إلى المعهد العالي للخدمة الاجتماعية سنة (1975م).
مقومات مهنة الخدمة
الاجتماعية:
حدد "أبراهام
فلكستر" عدة معايير اعتبرها ضرورية لقيام أي مهنة، وهي:
1)
ارتكاز
المهنة على عملية عقلية.
2)
ممارسة
المهنة تتطلب جهدًا فكريًا من الشخص الممارس.
3)
القدرة
على تطبيق معارفها النظرية.
4)
وضع
أهداف المهنة وأساليب تطبيقها.
5)
أن
يمارسها متخصصون.
6)
الاعتراف
المجتمعي بممارستها وممارسيها.
حدد علماء الخدمة
الاجتماعية العرب ستة معايير لمهنة الخدمة الاجتماعية، هي:
1.
القاعدة
العلمية:
تستند
الخدمة الاجتماعية على قاعدة علمية واسعة من العلوم الاجتماعية، فهي تأخذ من علم
النفس فهم الشخصية، والدوافع، والسلوك. ومن الصحة النفسية معرفة أسباب الأمراض
النفسية. ومن خلال علم الاجتماع تفهم المجتمع، والتغير الاجتماعي، وأسبابه،
وأشكاله، ونتائجه، والمشكلات المصاحبة له، وفهم العلاقات الاجتماعية، والجماعات،
والتركيب السكاني، والمشكلات الاجتماعية عمومًا، والنظريات المفسرة للظواهر
الاجتماعية. كما تستفيد من علوم أخرى مثل: علم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي،
والأنثروبولوجيا، والاقتصاد، والإحصاء.
تعتمد
الخدمة الاجتماعية على المنهج العلمي في دراستها، كالمنهج (المقارن، والتحليلي،
والوصفي، والتجريبي، والتاريخي... إلخ)، ومن الأدوات: (الملاحظة، والمقابلة،
واستبيان، ودراسة الحالة... إلخ)؛ لتساعد في تفسير المواقف الاجتماعية، والقدرة
على النقد والتقييم.
2.
طرق
الخدمة الاجتماعية:
تقوم
الخدمة الاجتماعية على ثلاث طرق رئيسية، هي: خدمة الفرد تأسست سنة (1917م)، وخدمة
الجماعة ظهرت سنة (1935م)، وتنظيم المجتمع
اعترف به سنة (1946م).
3.
الممارسة
المهنية:
المهارة:
"هي القدرة والرغبة في المساعدة وإحداث التغير المطلوب، يكون من خلال فهم
وإدراك الإطار النظري للمهنة".
من
المهارات المطلوب توفرها في الأخصائي الاجتماعي: الرغبة في المساعدة، الاتزان
الانفعالي، القدرة على تكوين علاقة مهنية مميزة، القدرة على تحليل الموقف... إلخ.
4.
وضع
أهداف المهنة:
هدف الخدمة الاجتماعية الارتقاء بمستوى
حياة الفرد، والجماعة، والمجتمع. هذه الأهداف تنبع من احتياجاتهم لتحسين مستواهم
المعيشي، وإدراك مشكلاتهم، وإحداث التغيرات المطلوبة في نظم المجتمع؛ لمواجهة
مشكلاتهم من خلال البرامج الوقائية، والعلاجية، والتنموية.
5.
الأخصائي
الاجتماعي:
تقوم معاهد، وكليات، وأقسام الخدمة الاجتماعية بإعداد أخصائي اجتماعي بعد التأكد من سلامته الجسمية، والنفسية، واستعداده الشخصي؛ حتى يتمكن من القيام بدوره على الوجه الأكمل. وتزوده بقاعدة علمية ومعرفية من العلوم الإنسانية ذات العلاقة كعلم النفس، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والإحصاء، والاقتصاد... إلخ، إلى جانب إخضاعه للتدريب في المؤسسات الاجتماعية، بهدف الربط بين الإطار النظري الذي تعلمه في الجامعة، والممارسة العملية في المؤسسات الاجتماعية.
6.
الاعتراف
المجتمعي:
من
علامات اعتراف المجتمع بمهنة الخدمة الاجتماعية:
أ. تزايد أعداد معاهد، وكليات، وخريجي
الخدمة الاجتماعية.
ب. عقد مؤتمرات تعنى بقضايا الخدمة
الاجتماعية.
ج. تقديم أبحاث ورسائل علمية لها علاقة بمهنة
الخدمة الاجتماعية.
د. الاحتياج الدائم للأخصائيين الاجتماعيين
في مجالات الحياة المختلفة.
تعريف الخدمة الاجتماعية:
v آرلين جونسون: "مهنة تؤدى للناس
كأفراد وجماعات لمساعدتهم على خلق علاقات مرضية ليصلوا إلى مستويات للحياة تتماشى
مع قدراتهم ورغباتهم في حدود أهداف المجتمع".
v ستروب: "فن يستخدم مختلف الموارد لسد
حاجة الفرد أو الجماعة أو المجتمع بطريقة علمية تعين الناس ليساعدوا أنفسهم".
v كينث براي: "تلك الجهود المنظمة
التي تخصص وتستخدم لمساعدة الأفراد والجماعات ليحصلوا على إشباع كامل لحاجاتهم عن
طريق مؤسسات اجتماعية، وتسير هذه العمليات في حدود مجتمع مستقر".
v الأمم المتحدة: "النشاط الموجه
والمصمم بقصد الوصول إلى مستوى أفضل لتكيف الأفراد وبيئاتهم الاجتماعية".
v يمكننا تعريف الخدمة الاجتماعية: "هي علم وفن تسعى إلى مساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات، وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية؛ لمنحهم القدرة على أداء أدوارهم ووظائفهم الاجتماعية بشكل طبيعي، وتحقق لهم التكيف والاندماج مع مجتمعاتهم".
أسس فهم مهنة الخدمة
الاجتماعية:
1.
الخدمة
الاجتماعية مهنة تستند على قاعدة علمية.
2.
تمارس
الخدمة الاجتماعية في مؤسسات اجتماعية حكومية وأهلية، وأولية وثانوية.
3.
للخدمة
الاجتماعية دور وقائي وعلاجي، وإمكانية التنبؤ بالمشكلة الاجتماعية قبل وقوعها،
وكيفية مواجهتها.
4.
تسعى
الخدمة الاجتماعية للاستفادة من كل طاقات المجتمع.
5.
يمارس
الخدمة الاجتماعية أخصائي معد لذلك إعدادًا علميًا ومهنيًا.
6.
تتنوع
مجالات الخدمة الاجتماعية، مثل: (الأسرة، والمدرسة، والمصنع، والطفولة، والشيخوخة،
والإدمان، والمرض النفسي والعقلي، والإعاقة والتأهيل المهني، والجريمة والانحراف،
والتنمية الريفية... إلخ).
7.
تعتمد
الخدمة الاجتماعية على التخطيط المنظم والمرحلي منذ بدء الدراسة حتى إنهاء العلاقة
المهنية.
8.
تسعى
الخدمة الاجتماعية إلى التعاون مع كافة النظم والمؤسسات الاجتماعية الموجودة في
المجتمع.
أهداف الخدمة الاجتماعية:
أولًا|
أهداف وقائية:
تركز
الخدمة الاجتماعية على الجانب الوقائي، فهي تعمل على توفير السبل الكفيلة لوقاية
الأفراد من الوقوع في المشكلات، وتعينهم على أداء أدوارهم الاجتماعية، والتكيف مع
بيئاتهم الاجتماعية. لتحقيق ذلك فهي تعمل على:
1.
المساهمة
في تحسين المستوى المعيشي للأفراد.
2.
نشر
الوعي بين الناس من خلال المحاضرات، والندوات، ووسائل الإعلام، والدورات
التدريبية.
3.
إجراء
دراسات ومسوح اجتماعية؛ بهدف التعرف على المشكلات الاجتماعية، وأسبابها، وسبل
علاجها.
4.
إحداث
التغيرات المرغوب فيها على صعيد الأفراد، والجماعات، والمجتمعات.
5.
مساعدة
الأفراد، والجماعات، والمجتمعات على استثمار الطاقات والإمكانيات المتوفرة لديهم لصالحهم.
6.
إحداث
تغيرات في النظم الاجتماعية القائمة؛ لإيجاد حل لمشكلات المجتمع والحد منها.
7.
التعاون
مع مؤسسات المجتمع الأخرى بهدف الوقاية من الوقوع كفريسة لمشكلات المجتمع.
ثانيًا|
أهداف علاجية:
تركز
الخدمة الاجتماعية على إعادة تأهيل الفرد، والجماعة، والمجتمع؛ لاستعادة قدراتهم
للقياد بالأدوار المأمولة منهم. في سبيل ذلك تعمل على:
1.
دراسة
مشكلات الأفراد، والجماعات، والمجتمعات وتشخيصها، ووضع الخطط العلاجية المناسبة.
2.
تقديم
المساعدات المادية والعينية إلى المحتاجين لمواجهة ظروفهم الطارئة.
3.
التركيز
على برامج التأهيل النفسي، والاجتماعي، والجسدي، والمهني؛ بهدف استثمار طاقات
الأفراد في تنمية المجتمع وتحسين أحوالهم.
4.
إنشاء
مراكز علاجية إيوائية أو نهارية.
ثالثًا|
أهداف تنموية:
لا
تقف الخدمة الاجتماعية عند حدي الوقاية والعلاج، بل تسعى لتحقيق تنمية الفرد، والجماعة،
والمجتمع من خلال إتباع الأساليب الآتية:
1.
المساهمة
في رسم السياسات الاجتماعية في المجتمع.
2.
إيجاد
صيغ تنموية تعترف بالتنمية الاجتماعية كركيزة أساسية إلى جانب التنمية الاقتصادية.
3.
تنمية
الشعور بالمسؤولية المجتمعية بين الناس، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق، والعمل
التطوعي.
4.
الاهتمام
بالتنمية الريفية والحضرية، وتحقيق التوازن بين احتياجات السكان وموارد المجتمع.
5.
رفع
المستوى الوعي بين الناس بمشكلات المجتمع، وضرورة السعي لحلها.
فلسفة الخدمة الاجتماعية:
1)
الإيمان
بقيمة وكرامة الإنسان.
2)
الإيمان
بالفروق الفردية بين الأفراد، والجماعات، والمجتمعات.
3)
حق
الفرد في ممارسة حريته في حدود تعاليم الدين وثقافة المجتمع.
4)
حق
الفرد في تقرير مصيره، مع عدم إلحاق الأذى والضرر بغيره.
5)
الإيمان
بأن لكل فرد طاقة وإمكانيات لها تأثير في تنمية المجتمع.
6)
الإيمان
بالعدالة الاجتماعية.
7)
الإيمان
بالحب والتسامح، ونبذ العنف والإساءة.
8)
الإيمان
بأن الآلام التي يعاني منها الفرد تؤثر على دوره الاجتماعي.
9)
الإيمان
بأن الإنسان أداة فعالة في تحقيق التغير الاجتماعي.
10) الإيمان بأن مساعدة الإنسان وقت الحاجة هي من تعاليم الدين.
مبادئ الخدمة الاجتماعية:
1.
مبدأ
التقبل:
التقبل:
"هو اتجاه عاطفي يصدر عن الأخصائي الاجتماعي نحو العميل. وتقبله على ما هو
عليه، وليس كما يجب أن يكون". من صوره: الاحترام، والتسامح، وتقدير المشاعر،
وتجنب النقد، والرغبة في المساعدة.
هذا
من شأنه تعزيز الثقة بين الأخصائي الاجتماعي والعميل، وتأسيس علاقة مهنية ناجحة
ومميزة.
2.
مبدأ
السرية:
السرية:
"هي حماية مقصودة لأسرار العملاء، وتجنب نشرها بين الناس".
تطبيق
مبدأ السرية يسهم في توفير أجواء الثقة والطمأنينة في نفس العميل، لذلك يجب على
الأخصائي الاجتماعي التأكيد على هذا المبدأ وإبراز أهميته منذ اللقاء الأول مع العميل.
لضمان
سرية المعلومات يجب أن يحفظ الأخصائي الاجتماعي ملفات العملاء في خزانات خاصة تكون
بعيدة عن متناول الآخرين والعبث بها، وإجراء المقابلات المهنية بعيدًا عن عيون
المتطفلين ومسترقي السمع.
3.
مبدأ
حق تقرير المصير:
حق تقرير المصير يعني: "ترك الحرية للفرد، أو الجماعة، أو المجتمع لتوجيه ذاته نحو الأهداف العامة والخاصة التي يراها في صالحه، ويمنح هذا الحق في حدود دين المجتمع وثقافته". إلا أنه توجد حالات تحرم من هذا الحق، مثل: (الأطفال الصغار، وحالات الإدمان الشديد، والمرض المعدي).
لتطبيق
هذا المبدأ يجب على الأخصائي الاجتماعي الآتي:
v توضيح كافة جوانب المشكلة إلى العميل.
v توضيح الإمكانيات والفرص المتاحة
لمواجهة المشكلة.
v مناقشة كافة الاقتراحات والآراء المقدمة
لحل المشكلة، والمخاطر الناجمة من تطبيق هذه الحلول.
v تلخيص الآراء التي تمت مناقشتها.
4.
مبدأ
العلاقة المهنية:
العلاقة
المهنية: "حالة من الارتباط العاطفي والعقلي الهادف بين الأخصائي الاجتماعي
والعميل، علاقة مؤقتة، لها وقت بداية ونهاية، تستند على حقائق علمية، ومهارات الأخصائي
الاجتماعي، ولا تتأثر بظاهر السلوك أو المعتقد".
5.
مبدأ
النقد الذاتي:
يهدف
النقد الذاتي للتعرف على مدى تحقيق أهداف البرنامج العلاجي، ويساعد الأخصائي
الاجتماعي والعميل في التعرف على ما تم التوصل إليه وإنجازه خلال عملية المساعدة.
6.
مبدأ
المشاركة:
أي
ضرورة مشاركة أطراف أخرى في دراسة المشكلة ووضع الحلول لها.
علاقة الخدمة الاجتماعية
بعلم الاجتماع:
علاقة
الخدمة الاجتماعية بعلم الاجتماع وثيقة، فعلم الاجتماع يهتم بدراسة الظواهر والنظم
الاجتماعية، والجماعات والعلاقات الاجتماعية بهدف التوصل إلى نظريات وقوانين علمية
تفسر طبيعة العلاقات الاجتماعية، في المقابل تستفيد الخدمة الاجتماعية من القوانين
الاجتماعية التي توصلت لها دراسات علم الاجتماع، فهي تساعد الأخصائي الاجتماعي في
فهم الظواهر والمشكلات الاجتماعية، ووضع خطط الإصلاح الاجتماعي؛ لتحقيق تكيف الأفراد
مع بيئاتهم الاجتماعية.
تعود
البدايات الأولى لعلاقة الخدمة الاجتماعية بعلم الاجتماع إلى الثورة الصناعية وما
خلفته من مشكلات اجتماعية جديدة، مثل: (الفقر، والبطالة، وعمالة الأطفال، وعمل
المرأة، والتفكك الأسري... إلخ).
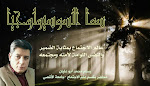
تعليقات
إرسال تعليق