 |
| د. بسام أبو عليان قسم علم الاجتماع - جامعة الأقصى |
الجماعات في خدمة الجماعة
تعددت
تعريفات الاتجاهات النظرية لمفهوم الجماعة، ويمكن الحديث عن أربعة اتجاهات رئيسية،
هي:
(1) الاتجاه البنائي الوظيفي:
اهتم بوصف عملية التفاعل الاجتماعي بين أعضاء الجماعة، والنظم الاجتماعية، وتأثر
الأدوار الاجتماعية بثقافة المجتمع السائدة.
(2) الاتجاه الصراعي:
اهتم بمظاهر الصراع داخل الجماعة، سواء كان صراعًا على المراكز، أو الأدوار، أو المصالح،
واهتم بعمليات الضبط الاجتماعي داخل الجماعة.
(3) اتجاه التفاعلية الرمزية:
اهتم بكشف المعاني والرموز التي يدركها الفرد لكل سلوك أو قرار في الجماعة.
(4) الاتجاه التبادلي:
أكد على أهمية تحليل سلوك الأفراد داخل إطار الجماعة.
تعريف الجماعة:
"وحدة
اجتماعية تتكون من فردين أو أكثر، تنشأ بينهم علاقات اجتماعية، قوامها التأثير
والتأثر، بحيث يتأثر الفرد بأفراد الجماعة الآخرين، ويؤثر فيهم، وتكون على درجة
كبيرة من التجانس، وغالبًا يكون لهم أهداف مشتركة يسعون إلى تحقيقها".
الفرق
بين الجماعة وصور التجمع الأخرى:
1.
التجمع:
التجمع:
"هو مجموعة أفراد متواجدين معًا في مكان ما، لكنهم غير متفاعلين".
هذا
التجمع من الناس لا يطلق عليه لفظ جماعة؛ لأنه انتفت عنه صفة أساسية من صفات
الجماعة، وهي: التفاعل الاجتماعي. مثال: تجمع مجموعة من الناس عند خروجهم من حفل،
أو ملعب رياضي، أو انتظار الأتوبيس... إلخ.
الجدير
بالذكر، لا تهتم خدمة الجماعة بهذا الشكل من أشكال التجمع.
2.
الفئة:
يطلق
لفظ الفئة على عدد من الوحدات الاجتماعية التي تشترك في صفات معينة في بعض
النواحي، وقد يتم تصنيف الفئات على أساس العمر، النوع، الصحة، الدخل، التعليم،
السكن، الدين، المهنة... إلخ.
هذا
النوع من التجمعات قد لا تتوفر فيه شروط التفاعل، وقد لا يتطلب الأمر ضرورة وجود
تفاعل أو تقارب مكاني بين أفراد الفئة الواحدة.
لا
تفيد هذه التجمعات خدمة الجماعة، لكنها تفيد في التحليل السوسيولوجي، والتحليل
الإحصائي للوصول إلى نتائج معينة.
3.
الجمهرة:
تعرف
الجمهرة: "هي حشد من الناس يستجيبون عاطفيًا لمثير مشترك، ويختلف عدد أفراده
من عدد قليل إلى عدد ضخم كبير".
قد
يكون الحشد عارضًا كتجمهر الناس في الشارع حول حادث طرق. وقد يتحول هذا الحشد إلى
حشد عدواني، هذا النوع من الحشد هو مثار اهتمام خدمة الجماعة.
خصائص الجمهرة:
v تشابه الاستجابات.
v وحدة الدافع والمثير.
v العاطفة الجارفة.
v السلوك العدواني والهمجي.
v الأحكام النهائية التي لا رجعة فيها.
v القابلية للاستهواء.
v ضعف الشعور بالمسؤولية الفردية.
v الزعامة المؤقتة.
4.
الجمهور:
يشبه
الجمهور الحشد في جوانب، ويختلف عنه في جوانب أخرى.
يعرف
الجمهور: "جماعة من الناس يسلكون سلوكًا جماهيريًا". مثل: الذين يتابعون
محاكمة معينة من خلال وسائل الإعلام.
خصائص الجمهور:
v قد يكون أفراد الجمهور من مراحل عمرية،
وطبقات اجتماعية، ومستويات اقتصادية، ودرجات علمية، ومهن مختلفة.
v يتكون الجمهور من أفراد على الغالب لا
يعرف بعضهم بعضًا.
v غالبًا لا يتم التفاعل وتبادل الخبرة بين
أفراد الجمهور، فهم متفرقون، وهم بذلك على نقيض الحشد.
v ليس لديهم تنظيم، بالتالي يعجز أفراد
الجمهور عن العمل المنظم، وهم بذلك على نقيض الحشد.
الجماعة في علم الاجتماع:
أبدى
علماء الاجتماع اهتمامهم بدراسة الجماعة منذ أوائل القرن العشرين، من جهود هؤلاء
العلماء:
v ليبون:
تعامل مع الجماعة الصغيرة (الحشد)، واهتم بوصف انتقال التأثير في الجماعات
الصغيرة.
v ماكدوجال:
درس طرق تحليل الأحداث على مستوى الجماعة.
v سيمل:
درس تأثير حجم الجماعة على علاقات أعضائها، فالجماعة المكونة من عضوين تنمو الروابط
تجاه بعضهما بشكل لا يوجد في الجماعات الكبيرة. كما درس تغير التفاعل عند إضافة عضو
ثالث للجماعة، وبين أن الجماعات الصغيرة تتطلب تفاعلًا أكبر من الجماعات الكبيرة.
v كولي:
هو أول من ميز بين الجماعة الأولية والثانوية، وبين دور الجماعة الصغيرة في تنشئة
الفرد، وترسيخ السلوك لديه.
v جيب:
طرح مفهوم "الجماعة الوظيفية"، باعتبارها علاقة بين اثنين أو أكثر؛
لتحقيق هدف مشرك بينهم.
v نيوكمب:
عرف الجماعة هي علاقة بين اثنين أو أكثر يسعون لتحقيق هدف مشرك، بشرط اشتراكهم في
المعايير، والتشابك في الأدوار.
v جونسون:
يرى أن كل جماعة تنشأ عن علاقة اجتماعية، وليس من الضروري أن تنشئ كل علاقة
اجتماعية جماعة.
v ماكيفر:
بيَّن أن الجماعة تتكون من أفراد يدخلون معًا في علاقات اجتماعية.
v ميريل:
الجماعة هي شخصان أو أكثر يتفاعلون لفترة زمنية مناسبة، ويشتركون في تحقيق هدف
مشترك.
v ثيودور ميلز:
اعتبر تشكيل الجماعات الصغيرة يكون من أجل تحقيق هدف معين، وميز بين مفاهيم: المجتمع،
والجماعة، والحشد، والتجمهر.
|
الحشد |
التجمهر |
|
عابر ومندفع |
غير مندفع |
|
وجود الإثارة، والحماس |
عدم وجود الإثارة، والحماس |
|
جمع من الناس في مكان واحد (مكان الحادث) |
مجموعة متفرقة من الناس |
|
لا يمكن إجراء مناقشة نقدية |
النقاش ضروري |
|
الأفراد لديهم اهتمامات مشتركة؛ لكنهم ليسوا
متشابهين في التفكير |
الأفراد يختلفون في الرأي حول القضايا
المشتركة |
|
الاتصال بين الأفراد وجهًا لوجه |
الاتصال ليس ضروريًا أن يكون وجهًا لوجه، بل
يكون من خلال وسائل الإعلام المختلفة |
|
عدوى السلوك من خلال الاتصال |
عدوى السلوك من دون اتصال |
|
عدده أقل |
عدده أكبر |
|
تجمع نشوة |
تجمع عقلاني |
v سميث:
عرف الجماعة: "مجموعة أعضاء يدركون وحدتهم الجماعية، ولديهم القدرة على العمل
المشترك".
v كرش وكرتشفيلد:
رأيا أن معيار تشكيل الجماعة، هو: التفاعل الجمعي، والديناميكي.
v همفيل:
حدد معايير قياس أبعاد الجماعة، وهي: الحجم، والاستقرار، والتضامن، والتجانس.
v جيجر:
عرف الجماعة: "مجموعة أشخاص يتحدون معًا، لدرجة يشعر معها الفرد أنه جزء من
كل مشترك، يعبر عنه بالضمير نحن".
الجماعة في خدمة الجماعة:
v
كولي:
حدد خصائص الجماعة الصغيرة:
أ-
العلاقات
مباشرة.
ب-
الطابع
التخصصي.
ج-
الاستمرار
النسبي.
د-
صغر
الحجم.
ه-
الألفة
النسبية في العلاقات الاجتماعية.
v هير:
بيّن أن حجم الجماعة المناسب هو من عضوين إلى عشرين عضوًا.
v كلاين:
حدد الحجم المناسب للجماعة:
أ- الحجم
المناسب للجماعة عمومًا: خمسة عشر عضوًا.
ب- حجم
الجماعة العلاجية: من تسعة إلى عشرة أعضاء.
ج- إن قل عدد أعضاء الجماعة عن خمسة تكون العلاقات
بينهم محدودة، ولا تفيد في إحداث التغير المرغوب فيه للأفراد.
د- إن زاد عدد أعضاء المجموعة عن ثلاثين عضوًا،
يصعب إقامة علاقات مباشرة وقوية بين الأعضاء، ولا نضمن استمرار الجماعة لأطول فترة
ممكنة، ويصعب على كل فرد المشاركة بجهده وقدراته في الأنشطة.
خصائص الجماعة:
1)يبدأ تكوين الجماعة من فردين أو أكثر.
2)صغر الحجم، حيث تسمح لأفرادها بسهولة
التواصل المباشر فيما بينهم.
3)التواصل المباشر بين أعضاء الجماعة يسمح
بقوة التماسك بينهم، وتوفر فرص المشاركة والإبداع.
4)يعرف الأعضاء بناءً على عضويتهم في الجماعة،
فالأول ينتمى إلى فريق رياضي، والثاني لهيئة تدريس، والثالث لنقابة عمالية،
والرابع لمجلس إدارة جمعية، وهكذا.
5)يكون للجماعة أهدف واضحة ومحددة بشكل
دقيق تسعى إلى تحقيقها.
6)لكل جماعة مجموعة معايير وقواعد تضبط
سلوك أعضائها.
7)لكل عضو في الجماعة مركز اجتماعي، يمنحه
قوة تمكنه من تسيير أنشطة الجماعة.
8)التنظيم في توزيع الأدوار، والمسؤوليات،
والقيادة، واتخاذ القرارات، ووضع اللائحة الداخلية، وتحديد شروط العضوية.
9)الرغبة في تقبل أخصائي
الجماعة، والمؤسسة، وإقامة علاقة تعاونية معهما.
10)التجانس
بين أعضاء الجماعة.
11)نمو
مشاعر الانتماء للجماعة يمنح الفرد امتيازات مادية ومعنوية.
12)حين
يدرك أعضاء الجماعة أنهم وحدة اجتماعية واحدة متماسكة، يعزز عندهم شعور الـ (نحن)
على شعور الـ (أنا).
المرجع| بسام محمد أبو عليان، خدمة الجماعة، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2021.
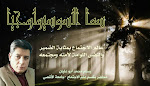
تعليقات
إرسال تعليق