 |
| د. بسام أبو عليان قسم علم الاجتماع - جامعة الأقصى |
أخصائي الجماعة
تعريف أخصائي الجماعة:
"هو
الفرد الذي أعد إعدادًا علميًا ومهنيًا لممارسة العمل مع الجماعات في مختلف مجالات
الخدمة الاجتماعية".
الصفات يجب توافرها في أخصائي الجماعة:
أولًا: الصفات الجسدية:
1.
السلامة
الجسدية، وسلامة الحواس، واللياقة البدنية.
2.
الميل
إلى الحركة والنشاط.
ثانيًا: الصفات الشخصية:
1.
المظهر
الخارجي الحسن، والهندام المرتب، والرائحة الطيبة.
2.
الوجه
البشوش، والابتسامة الدافئة، والروح المرحة، والكلمة الطيبة.
3.
الإخلاص
والصدق في العمل.
4.
التحلي
بالصبر، والحلم، والأناة، وسعة الصدر، والاتزان الانفعالي.
5.
الإصغاء
الجيد للحديث.
6.
احترام
ذاته، ومعرفة ما يتمتع به من قدرات وإمكانيات.
7.
الثقة
بالنفس.
8.
سعة
الاطلاع، والتعرف على آخر المستجدات في مجال عمله وتخصصه.
ثالثًا: الصفات النفسية والانفعالية:
1. الاتزان الانفعالي وضبط النفس.
2. حب الناس والقدرة على التفاعل مع
الآخرين.
3. الذكاء، وحسن التصرف، والمرونة.
4. المبادرة، واليقظة.
5. الكفاءة، والخبرة في العمل المهني.
6. الثبات، والاستقرار في المعاملة.
7. القدرة على الاستجابة لحاجات الأعضاء.
8. القدرة على الإنصات والإصغاء والتواصل
مع الأعضاء.
رابعًا: الصفات الاجتماعية:
1.
الانفتاح
على الآخرين من خلال نسج علاقات طيبة وودودة مع الآخرين.
2.
حب
التعامل مع الناس، والمبادرة لتقديم المساعدة لمن يستحقها.
3.
القدرة
على قيادة الآخرين، وتقديم التوجيه والنصح المناسب لهم.
4.
فهم
عادات، وتقاليد، وقيم المجتمع واحترامها.
5.
القدرة
على الإقناع، والاقتناع.
6.
الشعور
بالمسؤولية المجتمعية.
خامسًا: الصفات العقلية والمعرفية:
1.
الإلمام
بالعلوم التي لها علاقة بالخدمة الاجتماعية؛ حتى يستفيد منها في المواقف المناسبة.
2.
أن
يكون متابعًا للتقدم العلمي والتكنولوجي، والقدرة على توظيفه في مجال عمله مع
الجماعات.
3.
القدرة
على تحليل الذات والآخرين، والنقد البناء، والتقييم المستمر.
4.
أن
يلتزم بفلسفة الخدمة الاجتماعية.
5.
القدرة
على إدارة الحوار والنقاش، وتلخيص وجهات النظر المتخلفة، والإقناع.
6.
أن
يكون قادرًا للتعبير عن نفسه بوضوح، وعرض أفكاره بشكل منظم.
7.
القدرة
على نقل خبراته ومهاراته إلى الآخرين.
8.
الذكاء.
سادسًا: الصفات المهنية:
1.
حب
المهنة، واحترامها.
2.
الإلمام
بأخلاقيات الممارسة المهنية.
3.
القدرة
على فهم وتوظيف نظريات وتقنيات الممارسة المهنية.
4.
تطوير
المهارات المهنية من خلال حضور الأيام الدراسية، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات
العلمية.
5.
تطوير
المهارات الإدارية: كإدارة الوقت، والاتصال والتواصل، وكتابة التقارير.
6.
القدرة
على نسج علاقة مهنية ناجحة مع أعضاء الجماعة تتسم بالود والاحترام، وتجنب تعمّد
الإساءة لأعضاء الجماعة سواءً بالتصريح أو التلميح.
7.
الحفاظ
على حدود العلاقة المهنية، والابتعاد عن شخصنتها.
8.
العمل
لصالح الجماعة.
9.
التحلي
بالموضوعية، والتحرر من كل صور التعصب والتحيز للون، أو الجنس، أو الدين، أو
العرق، أو المناطقية... إلخ.
10.
فهم
عادات، وتقاليد، وأعراف، وقيم المجتمع والتحرك مع الجماعة بموجبها.
11.
التحلي
بالصدق في وصف المشكلة بشكل واضح وصحيح دون تهويل أو تقليل من خطورتها.
12.
احترام
الوقت، وحسن إدارته.
13.
القدرة
على إجراء وإدارة المقابلة المهنية.
14.
القدرة
على التصرف في المواقف الصعبة والحرجة.
15.
الحفاظ
على سرية المعلومات، وطمأنة أعضاء الجماعة لذلك.
16.
إعداد
ملف لكل حالة، به كل المستندات والوثائق المطلوبة.
17.
التمتع
بمهارة الإصغاء الفعال، والفهم الصحيح لمعاني حركات وكلمات أعضاء الجماعة،
والابتعاد عن افتراض المعاني، والأحكام المسبقة، ومنح العضو مساحة كافية ليعبر عن
مشكلته بأريحية.
18.
التأني
عند تشخيص المشكلة، وتصميم الخطة العلاجية، والبدء في تنفيذها.
19.
التمتع
بمهارة صياغة الأسئلة، والابتعاد عن الأسئلة شديدة الخصوصية في حياة العضو التي لا
علاقة لها بصلب المشكلة.
20.
العمل
على تعزيز ثقة العضو بنفسه.
21.
تحفيز
العضو على المشاركة في أنشطة الجماعة.
22.
مساعدة
أعضاء الجماعة على كيفية التعامل مع مشكلاتهم النفسية، والأسرية، والاجتماعية.
23.
التنسيق
مع مؤسسات المجتمع؛ لتقديم الخدمات المناسبة للجماعة.
24.
القدرة
على اتخاذ القرارات المهنية اللازمة.
25.
الاستفادة
من تجارب الآخرين.
26.
الإلمام
باللوائح والتشريعات المعمول بها في المؤسسة.
27. التمتع بعلاقة طيبة مع مرؤوسيه وزملاءه في
العمل.
28.
القدرة
على المبادرة والتأثير.
خصائص السلوك المهني لأخصائي الجماعة:
1) المبادأة
والابتكار: تنتظر الجماعة من الأخصائي الاجتماعي أن
يكون مبادئًا، وقادرًا على الإبداع والابتكار في المواقف الاجتماعية، وأكثر مثابرة
وحماسًا.
2)
التفاعل
الاجتماعي: تتوقع الجماعة من الأخصائي الاجتماعي
أن يكون محركًا لعملية التفاعل داخل الجماعة، وأن يكون ودودًا في الاستجابات الانفعالية.
3)
التكامل:
يعمل الأخصائي الاجتماعي على تخفيف حدة التوترات داخل الجماعة، ويعمل على لم شمل
الجماعة، وتدعيمها.
4)
التخطيط:
يقوم الأخصائي الاجتماعي مع أعضاء الجماعة بالتخطيط لبرامج وأنشطة الجماعة.
5) التوافق
النفسي والمهني: يأتي ذلك من خلال التزام الأخصائي الاجتماعي
بالقيم المهنية للخدمة الاجتماعية.
دور أخصائي الجماعة كمساعد للجماعة:
(1) مساعدة أعضاء الجماعة لوضع أهداف مشتركة
للجماعة.
(2) ينمي لدى أعضاء الجماعة التفكير الواقعي،
ويشجعهم للمساهمة في تصميم برامج وأنشطة الجماعة.
(3) يعلم أعضاء الجماعة المبادرة في تنفيذ البرامج،
وتوزيع المسؤوليات عليهم.
(4) يساعد أعضاء الجماعة لوضع القواعد العامة
التي تحكم سلوكهم.
(5) التأكيد على أن لكل مركز قيادي في
الجماعة دور وظيفي، وليست مسميات فقط.
(6) مساعدة أعضاء الجماعة لاختيار الأنشطة
الجماعية.
(7) الاهتمام بقدرات أعضاء الجماعة
وإمكانياتهم، وتدارك مشكلاتهم والعمل على حلها.
(8) التعرف على المصادر التي يمكن الاستعانة
بها من داخل المؤسسة أو خارجها.
(9) دراسة الجماعة باعتبارها أساس عملية
المساعدة.
(10) العمل
على نمو وتطور الجماعة.
(11) استثارة
التفاعل الجمعي بين أعضاء الجماعة؛ لاكتساب الخبرات الجماعية.
(12) التعامل
مع مشكلات الجماعة من خلال: التعرف على أسبابها، ودراستها، ووضع الحلول لها.
(13) مراعاة
الفروق الفردية بين أعضاء الجماعة سواء في الأنشطة الجماعية، أو المقابلات
الفردية.
(14) العمل
مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى الموجودة في المجتمع.
العوامل المؤثرة في دور أخصائي الجماعة:
أولًا: العوامل الشخصية التي تؤثر على
دور أخصائي الجماعة:
1.
درجة
احترامه لأعضاء الجماعة، وتقبل الجماعة كما هي.
2.
درجة
إدراكه أنه يعمل مع الجماعة.
3.
درجة
إدراكه أن يعمل على مساعدة أعضاء الجماعة قدر الإمكان.
4.
خبراته
السابقة في العمل مع الجماعات، وقدرته على تفهم حاجات الجماعة.
5.
قيمه
ودرجة ارتباطها بقيم المجتمع.
6.
درجة
استعداده لمساعدة أعضاء الجماعة لتعبير عن أنفسهم.
7.
درجة
استعداده لمساعدة الجماعة دون أن ينتظر منها جزاءً.
8.
درجة
إلمامه ومعرفته بالمؤسسة التي يعمل فيها.
9.
قدرته
على استثمار الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة والبيئة الاجتماعية لمساعدة الجماعة.
10. مهاراته
في تصميم البرامج والأنشطة.
11. قدرته على ضبط نفسه في المواقف المختلفة.
ثانيًا: العوامل الخارجية التي تؤثر
على دور أخصائي الجماعة:
1.
ثقافة
المجتمع.
2.
المؤسسة
الاجتماعية، وأهدافها، وبرامجها.
3.
الإمكانيات
التي توفرها المؤسسة للأخصائي الاجتماعي.
4.
نوع
المؤسسة التي يعمل معها الأخصائي الاجتماعي.
5.
المستوى
الجسدي، والعقلي، والانفعالي، والصحي لأعضاء الجماعة.
6.
حاجات،
ورغبات، وقدرات أعضاء الجماعة.
7.
درجة
تقبل الجماعة للأخصائي الاجتماعي، والمؤسسة الاجتماعية.
المواقف التي يعمل في أخصائي الجماعة مع الأفراد:
1.
مساعدة
العضو الجديد، فهو يعطيه نبذة عن مختلف الجماعات التي يمكنه الانضمام إليها،
ويساعده على اختيار الجماعة المناسبة له.
2.
مساعدة
العضو؛ ليصبح عضوًا فاعلًا في الجماعة، وتقديمه للأعضاء الآخرين في الجماعة.
3.
يساعد
الأعضاء الذين تولوا مهام ومسؤوليات في الجماعة كقائد الجماعة، وأمين السر، وأمين
الصندوق... إلخ.
4.
مساعدة
الأعضاء الذين يلاقون صعوبة في تنفيذ المهام المطلوبة منهم.
5. مساعدة الأعضاء الذين يلاقون صعوبة في التكيف مع أعضاء الجماعة.
6.
ينمي
مهارات الأعضاء الذين يتمتعون بمهارات معينة وبارزة.
7.
يساعد
الأفراد على الانسحاب من الجماعة التي لا توافق ميولهم واهتماماتهم.
8.
يساعد
الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة خارجية.
دور الأخصائي الاجتماعي مع العضو الذي يجد صعوبة في التكيف مع الجماعة:
إذا
لم يستطع العضو التكيف مع الجماعة، على الأخصائي الاجتماعي أن يقوم بثلاث خطوات
لعلاج هذه المشكلة، وهن:
1)
معرفة
دوافع العضو تجاه الجماعة.
2)
معرفة
الأخصائي الاجتماعي مدى استجابته نحو هذا العضو.
3)
معرفة
مدى تأثير هذا العضو في الجماعة، وكيف تستجيب الجماعة له.
الحالات التي يجب على
الأخصائي الاجتماعي الاهتمام بها:
1)
الأعضاء
الذين لديهم رغبة للسيطرة على الآخرين، على الأخصائي الاجتماعي كبح جماح سيطرتهم؛
ليتمكنوا من التكيف والتعايش مع الجماعة.
2)
الأعضاء
الخجلون، والمنعزلون، والمنغلقون على أنفسهم، يجب على الأخصائي الاجتماعي مساعدتهم
على التكيف مع الجماعة، والتفاعل مع الأعضاء، والمشاركة في أنشطة الجماعة.
3)
الأعضاء
المتواكلون الذين يعتمدون على الأخصائي الاجتماعي أو على زملائهم في تنفيذ المهام
المطلوبة منهم، يجب أن يكلفهم الأخصائي الاجتماعي بأعمال معينة، ويتابعها ليتأكد
من القيام بها وتنفيذها.
4)
الأعضاء
الذين يتسمون بالسلبية، يحاول الأخصائي الاجتماعي استبدالها بالجوانب الإيجابية.
5)
الأعضاء
الذين لا يلتزمون بالقواعد والأنظمة المعمول بها في الجماعة، يحاول الأخصائي
الاجتماعي مساعدتهم لتقبل هذه القواعد، وحثهم على ضرورة الالتزام بها، إن التزموا
يثابوا، وإن خالفوا يعاقبوا.
6)
الأعضاء
الذين لديهم فكرة خاطئة على المؤسسة الاجتماعية، أو الجماعة، أو أعضاء الجماعة،
يقوم الأخصائي الاجتماعي بتصحيح معلوماتهم الخاطئة.
7)
الأعضاء
الذين يستغلون الجماعة للتنفيس عن مشكلاتهم الخاصة، ينبه الأخصائي الاجتماعي العضو
على ضبط سلوكه.
8)
الأعضاء
الذين يميلون إلى استخدام العنف في علاقاتهم بالآخرين، يحاول الأخصائي الاجتماعي
أن يهتم بهم اهتمامًا خاصًا ليعينهم على التخلص من هذا السلوك السيء.
المرجع| بسام محمد أبو عليان، خدمة الجماعة، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2021.
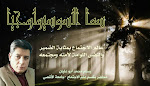
تعليقات
إرسال تعليق