 |
| د. بسام أبو عليان قسم علم الاجتماع - جامعة الأقصى |
العوامل المؤثرة في دراسة التغير الاجتماعي:
أولًا: العامل التكنولوجي:
تعرف
التكنولوجيا: "دراسة القواعد العلمية للفنون، والصناعات المستعملة في
المجتمعات الرشيدة دون غيرها". وتعرف أيضًا: "الوسائل التقنية التي
يستخدمها الناس في وقت معين من أجل التكيف مع البيئة الفيزيقية".
ترتبط
التكنولوجيا بالمجتمع ارتباطًا وثيقًا، فهي انعكاس لثقافة المجتمع، وتعبر عن مدى تقدم
المجتمع الحضاري.
علم
الاجتماع لا يهتم بالتكنولوجيا اهتمامًا مجردًا، إنما يهتم بآثار التكنولوجيا
الاجتماعية.
العلاقة
بين التكنولوجيا والمجتمع متبادلة، فالحاجة الاجتماعية تتطلب اختراع آلات جديدة،
وهذه الآلات تحدث آثارها في المجتمع. لذلك، يرى أنصار النظرية التكنولوجية أن سبب التغير
الاجتماعي هو التكنولوجيا؛ فأي اختراع تكنولوجي يؤثر على نظم المجتمع المختلفة السياسية،
والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية... إلخ.
ساهمت
التكنولوجيا في تكوين عدة اتجاهات داخل المجتمع، منها:
1. التخصص في العمل.
2. إيجاد ظاهرة الإمبريالية، الناتجة عن
الثورة الصناعية، ففائض الإنتاج في الدول الصناعية، جعلها تبحث عن أسواق جديدة
لتصريف المنتجات لها من جهة، وتسيطر على مواردها الخام من جهة أخرى. وقد تشكلت
الإمبريالية على وجهين: الاستعمار المباشر قديمًا، والشركات متعددة الجنسيات
حديثًا، فترتب على هذه الإمبريالية تبعية الدول النامية للدول الصناعية المتقدمة.
3. تغير القيم الاجتماعية القديمة نحو
الوقت، والمرأة، والعمل... إلخ، وحلت محلها قيمًا جديدة؛ لتتوافق مع التقدم
التكنولوجي، فهذا أسهم في زيادة تراكمات التغيرات الاجتماعية.
ترتب
على سرعة التغير في جانب الثقافة المادية، وتباطؤ التغير في جانب الثقافة غير
المادية ما أطلق عليه أوجبرن "الهوة الثقافية"، وهذا يعود لعدة أسباب،
هي:
§
المحافظة
على القديم، والخوف من الجديد.
§
الجهل
بحقيقة التجديد والاختراع، وعدم معرفة كيفية استخدامه تفضي بالنهاية إلى رفضه.
§
النزعة
المحافظة لدى كبار السن.
§
إستاتيكية
العادات والتقاليد الاجتماعية.
وقد
درس "نمكوف" أثر التطور التكنولوجي على الأسرة فخلص إلى النتائج الآتية:
1) أدت الصناعة إلى خفض الإنتاج المنزلي،
الأمر الذي أدى إلى إلغاء دور الأب في العمل الزراعي، واليدوي.
2) ترتب على عمل الرجل خارج المنزل، تحميل
المرأة مسؤولية تدبير شؤون البيت، وتربية الأبناء.
3) خروج المرأة إلى العمل منحها استقلالها
الاقتصادي، وتعزيز مكانتها الاجتماعية، وتدعيم فكرة المساواة بين الجنسين.
4) بفعل التطور التقني نشأت المدن الصناعية،
والمجتمعات الحضرية، ونمو الخدمات العامة، وإسنادها إلى مؤسسات تابعة للدولة.
على
الطرف المقابل ظهر مجموعة من العلماء رفضوا فكرة أن التغير الاجتماعي يعود للعامل
التكنولوجي فقط، منهم" "ديروبرتي"، الذي بين أن الثقافة تنقسم إلى
أربعة أقسام، هي:
v التفكير التحليلي، أي العلم.
v التفكير التركيبي، أي الفلسفة، والدين.
v التفكير الرمزي، أي الفنون.
v التفكير التطبيقي، أي بقية جوانب
التكنولوجيا.
في
حالة التغير يلاحظ أن العلم هو أول ما يتغير، والتكنولوجيا هي آخر ما يتغير، فهنا
تحدث الفجوة الثقافية، حيث تتخلف الماديات عن اللا ماديات. يرى "سوروكين"
أن التغير في جوانب الثقافة اللامادية أسرع من التغير في الجوانب المادية؛ لأن
الظواهر الدينية، والعلمية، والاقتصادية تصل فكرتها إلى الآخرين أولًا، ثم يبدأ
تأثيرها في الجوانب المادية.
خلاصة القول: القائلون
بالهوة الثقافية يتفقون في محاور ويختلفون في أخرى.
محاور الاتفاق:
v التقسيم الثنائي للثقافة (مادية، ولا
مادية)، وعدم تزامن التغيير في جانبي الثقافة المادية، واللامادية.
v الارتباط بين جانبي الثقافة، بحيث يؤثر
كل منهما في الآخر.
v التغير الاجتماعي يستغرق وقتًا من الزمن.
محاور الاختلاف:
v لا تتأثر الثقافة اللامادية بالثقافة
المادية، قال بذلك ابن خلدون، ودوركايم.
v توجد مجتمعات اليوم تقدمت في النواحي
اللامادية، لكنها لم تتقدم في النواحي المادية، كالمجتمع العربي تقدم في التعليم،
لكنه لم يتقدم في التكنولوجيا.
v صعوبة قياس مدى التغير الذي حدث في المجتمعات،
الأمر الذي يستدعي النسبية، والأحكام القيمية.
ثانيًا: العامل الديموغرافي:
يقصد
بالديموغرافيا: مجموع العناصر المتعلقة بالهيكل السكاني، من حيث الزيادة،
والنقصان، والكثافة السكانية، والتخلخل السكاني، والتوزيع السكاني، والهرم
السكاني.
بدأ
الاهتمام بالمسألة الديموغرافية مع بداية الثورة الصناعية؛ لأن الطلب زاد على
الأيدي العاملة، فالعمال يشكلون ركنًا أساسيًا في عملية الإنتاج، وكل عملية
إنتاجية تتوقف على عدد العاملين فيها.
الحركة
السكانية في المجتمع تتأثر بعوامل، هي:
v المواليد.
v الوفيات.
v الهجرة.
v الحروب.
v الأمراض والأوبئة.
وقد
أكدت الدراسات على وجود علاقة وطيدة بين السكان، وقضايا تقدم وتخلف المجتمعات، أي توجد
علاقة بين الديموغرافيا والتغير الاجتماعي. فقد أكد "دوركايم" على أن
تقسيم العمل أحدث تغيرات جذرية في المجتمع بالانتقال من التضامن الآلي إلى التضامن
العضوي. يعود ذلك إلى خصائص المجتمع السكانية من حيث حجم السكان، والتوزيع
السكاني، والأعمال التي يقومون بها، ووسائل العمل التي يستخدمونها. وأكد بأن تقسيم
العمل يسهم في التقدم الاجتماعي. وقد توصل إلى وجود علاقتين، هما:
أ. نمو الكثافة السكانية يصاحبه تقسيم
العمل.
ب. تقسيم العمل يؤدي إلى التقدم الاجتماعي،
والاقتصادي، والثقافي.
ثالثًا: العامل الأيكولوجي:
الأيكولوجيا:
"هي البيئة الجغرافية". تركز الدراسات الأيكولوجية على دراسة آثار البيئة
المباشرة على الحضارة المادية، والفكرية للشعوب ذات الوسائل التكنولوجية البسيطة.
أنواع الأيكولوجيا:
للأيكولوجيا
أنواعًا وفروعًا عديدة،
منها:
أ. الأيكولوجيا البشرية:
تهتم بدراسة العلاقة بين الإنسان، والبيئة الطبيعية، والبيئة الاجتماعية،
والعمرانية، من خلال التوزيع المكاني والزماني للأفراد، والجماعات، والخدمات في ظل
ظروف معينة.
ب. الأيكولوجيا الاجتماعية:
تدرس البيئة الاجتماعية، ومؤسساتها، والعلاقات الاجتماعية، والآثار المتبادلة بين
البيئتين الاجتماعية والطبيعية.
النظرية
الأيكولوجية تفسر التغير الاجتماعي على أساس ظروف البيئة الخارجية المفروضة على
المجتمع، فقد أكد "جالبن" على وجود علاقة بين أنشطة الأفراد، والظروف
البيئية. وربط "بيرجس" بين الظواهر الاجتماعية، والظواهر الطبيعية،
مؤكدًا أن المناطق المتخلفة مأوى للجريمة، والرذيلة، والفساد الأسري، والأمراض.
وفي ذلك مبالغة من بيرجس تجاه المناطق المتخلفة، حيث أن الرذيلة والفساد موجدان في
كل المناطق سواء كانت متخلفة أو متقدمة.
يعد
"ابن خلدون" من أوائل الذين ربطوا بين الجانبين الأيكولوجي، والاجتماعي،
فقد رأي أن النمو السكاني يتطلب توفير تخصصات ووظائف جديدة تدر دخلًا أكبر على
الأفراد؛ لاعتقاده أن النمو السكاني يزيد في المدن أكثر من البادية. فسكان المدن
أكبر حجمًا، وأكثر رفاهية مقارنة بالبادية الأقل كثافة سكانية، وهذا راجع لاختلاف
المهن التي تمارس في كل بيئة اجتماعية.
حدد
ابن خلدون دورة تطور المجتمع في ثلاث مراحل: (النشأة والتكوين، ثم الازدهار، ثم
الاضمحلال والانهيار). فكل مرحلة تشهد تغيرات اجتماعية وسكانية، أبرزها في
المرحلتين الأولى والأخيرة. إذ تشهد المرحلة الأولى زيادة معدلات المواليد، ونقص معدل
الوفيات، مما يعني زيادة سكانية. أما المرحلة الأخيرة تشهد انخفاض معدلات المواليد،
وزيادة معدلات الوفيات؛ بسبب الفقر، والجوع، والحروب، والأمراض، مما يعني نقصان
الزيادة السكانية.
في
موضع آخر تحدث ابن خلدون عن تأثير الهواء في بشرة السكان، فمناطق الجنوب حارة، ومناطق
الشمال باردة. هذا انعكس على العلوم، والمهن، والمباني، والملابس، والطعام،
والحيوانات، وجميع مكونات المجتمع، فضلاً عن اختلاف أحجام أجسام الأفراد،
وألوانهم، وأخلاقهم. فمن خصائص سكان المناطق المعتدلة: التوسط في بيوتهم، وملابسهم،
وطعامهم، ومهنهم. بيوتهم مشيدة بالحجارة، آنيتهم من المعادن، ينتشر بينهم (الذهب،
والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والقصدير). معاملاتهم النقدية بالذهب والفضة. هؤلاء
هم أهل (المغرب، والشام، والحجاز، واليمن). أما خصائص سكان المناطق الحارة:
بشرتهم سوداء، بيوتهم من الطين والقصب، طعامهم من الذرة والعشب، ملابسهم من أوراق
الشجر أو الجلود، أكثرهم عرايا. معاملاتهم النقدية من النحاس أو الحديد. أخلاقهم
قريبة من أخلاق الحيوانات العجم، يسكنون الكهوف، متوحشون. من الناحية الدينية لا
يعرفون نبوة، ولا يدينون بشريعة سماوية، إلا من اقترب من المناطق المعتدلة.
أخلاقهم يغلب عليها الخفة، والطيش، وكثرة الطرب، مولعين بالرقص، موصوفين بالحمق. أما
خصائص سكان المناطق الباردة: بشرتهم بيضاء، عيونهم زرقاء.
إن
اقتصار ظاهرة التغير الاجتماعي على العامل الأيكولوجي فقط، نظرة فيها قصور؛
للأسباب الآتية:
1. تأثير البيئة يكون قويًا كلما كان
المجتمع بسيطًا، وتقدمه ناقصًا؛ لأنها تعتمد على الموارد الطبيعية اعتمادًا
أساسيًا، أما المجتمعات المتقدمة يكون اعتمادها على موارد الطبيعة أقل؛ لاستخدامها
التكنولوجيا.
2. إذا كانت الطبيعة تؤثر في النظم
الاجتماعية، فإن النظم الاجتماعية تؤثر في الطبيعة أيضًا, بالتالي لا يمكن دراسة
الأيكولوجيا بعيدًا عن النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي،
والتعليمي... إلخ، فضلًا عن تأثير الظواهر الاجتماعية ببعضها.
3. البيئة الطبيعية باعتبارها عاملًا
مستقلًا لا تستطيع تفسير تغير الظواهر الاجتماعية باعتبارها عاملًا تابعًا؛ لأن
العامل الدائم يفسر التغير في حالة واحدة، لكنه لا يستطيع تفسير استمرارية التغير،
مما يعني وجود عوامل أخرى تسهم في حدوث التغير الاجتماعي.
4. توجد نظم اجتماعية متشابهة في المجتمعات
رغم اختلاف بيئاتها، وتوجد نظم اجتماعية مختلفة في المجتمعات رغم تشابه العوامل
البيئية. كذلك هناك اختلاف في الظواهر الاجتماعية داخل المجتمع الواحد، الأمر الذي
يقلل من حتمية تأثير الطبيعة في النظم الاجتماعية.
رابعًا: العامل الاقتصادي:
تعتمد
النظرية الاقتصادية في تفسيرها للتغير الاجتماعي على البناء الاقتصادي للمجتمع،
وتأثيره على العلاقات الاجتماعية، فالنشاط الاقتصادي يتحكم في حياة المجتمع
السياسية، والفكرية، وليس العكس.
تعرف
النظرية الاقتصادية بالنظرية الماركسية، التي تتبنى الحتمية الاقتصادية، فهي تعتبر
العامل الاقتصادي هو العامل الرئيس المحدد لبناء المجتمع وتطوره.
طُرِحت
النظرية الماركسية في منتصف القرن التاسع عشر، وتم تطبيقها عمليًا في القرن العشرين،
تحديدًا سنة 1917م، مع قيام الثورة البلشفية ضد النظام القيصري الروسي، وتشكيل
الاتحاد السوفييتي. وبقي معمولًا بها حتى انهيار الاتحاد السوفييتي أواخر
الثمانينات ومطلع تسعينات القرن الماضي، إلا أن التراث الماركسي لازال موجودًا،
وهناك دولًا لازالت تتبناه كالصين.
أفكار
"كارل ماركس" تولدت نتيجة تأثره بفلسفة "هيجل" التي طورت على
يد "فيورباخ"، لاسيما في مسائل: (الوعي، والطبقة الاجتماعية، والاغتراب،
وروح المجتمع، والبناء الفوقي والتحتي، والديالكتيك). إلا أن البعد الفلسفي في
النظرية الماركسية لا يمثل دراسة فلسفية مستقلة، إنما هو أحد عناصر النظرية.
اشتهرت
الماركسية أنها فلسفة مادية، حيث تعتبر المادة (الأشياء) هي جوهر العالم، والإنسان
خاضع لقوانين الطبيعة كأي شيء مادي آخر. مما يعني إنكار كل ما هو غير مادي (الروحي،
والغيبي). واعتبرت البحث في الغيبيات عمل عبثي؛ لأنه لا يقدم حلولًا لمشكلات
الواقع، ولا يفسر حركة تطور الأشياء والأفراد. إلا أنها اعتبرت الإنسان يختلف عن
الأشياء المادية الأخرى؛ لأنه قادر على اختراع الأدوات التي تساعده على تلبية
حاجاته.
لا
يؤمن "ماركس" بوجود حقائق خالدة وعامة عن الأفراد والمجتمعات تصدق في كل
زمان ومكان، بل يعتقد أن كل تقدم تكنولوجي يحمل في طياته أفكارًا عقلية وأخلاقية
خاصة به، وهذه لا تولد بمعزل عن حياتهم الاجتماعية.
التاريخ
في نظر "ماركس" هو تاريخ "الصراع الطبقي"، فالتطور التاريخي
يتكون من الحاجات المادية، والاختراعات التكنولوجية. والصراع الاجتماعي هو صراع
طبقي من أجل المصالح. حيث تستخدم الطبقة المسيطرة الأفكار كسلاح، وتجند كل القوى
الاجتماعية لبسط سيطرتها ونفوذها على المجتمع، أما الطبقة المستَغلة تقبل الأفكار
دون وعي، رغم أن تلك الأفكار لا تخدم مصالحها.
الخطوط العريضة لنظرية المعرفة الماركسية:
1. الفكر انعكاس للعالم المادي الخارجي
بشقيه الطبيعي، والاجتماعي.
2. الفكر هو أحد النتاجات المادية، ولا
يصدر عن بُعد روحي في الإنسان.
3. الفرد لا يوجد في فراغ، بل يوجد في وسط
اجتماعي من صفاته التغير.
4. تؤكد المادية الماركسية أنه لا وجود
للجزء دون الكل، ولا وجود للشكل دون المضمون، بل هو وجود مندمج ومتكامل غير قابل
للانقسام.
قسّم
"ماركس" البناء الاجتماعي إلى بنائين:
·
البناء
الفوقي: يشمل التشريعات، والنظم، والقوانين، والدين، والفن، والثقافة... إلخ.
·
البناء
التحتي: يتكون من قوى، وعلاقات، ونمط الإنتاج. أي (البناء الاقتصادي).
اعتبر
"ماركس" مفهوم الطبقة الاجتماعية جوهر البناء الاجتماعي. وقسم المجتمع
إلى طبقتين رئيسيتين، هما: البرجوازية (الرأسمالية): قلة يملكون وسائل الإنتاج.
والطبقة الأخرى العمال (البروليتاريا): يمثلون غالبية المجتمع، يعملون كأجراء عند
أصحاب رأس المال.
بيّن
أن الطبقة البرجوازية تستطيع لفترة من الزمن أن تحقق انسجامًا مع الحياة
الاقتصادية، وتنتج تعريفات لقيم وسلوكيات تتفق مع مصالحها. إلا أن هذا الوضع لا
يستمر طويلًا، فسرعان ما تضطرب الأوضاع ويظهر على السطح طبقة اجتماعية جديدة هي
البروليتاريا، تغير ظروف الإنتاج. إلا أن الطبقة المسيطرة لا تدرك هذا التغير
بسرعة، وتبالغ في الدفاع عن مصالحها لمواجهة الطبقة الجديدة.
التناقض
الذي تقع فيه الطبقة البرجوازية بين الفكر والممارسة يشكل الوعي الزائف لدى
الجماهير. وتركز النظريات الحديثة على أن "الوعي الزائف" ناتج عن خلل في
التوازن بين ثلاثة أشياء، هي:
أ. الذات: مجال الأفكار.
ب. الموضوع: عالم الأشياء المادية
الواقعية.
ج. وسائل التقييم التي تتوسط بين الذات
والموضوع.
حينما
يصف أحدًا أي خطاب أنه يمثل وعيًا زائفًا؛ لأنه يكون قد فهم العلاقة بين تلك
الأطراف الثلاثة فهمًا خاطئًا.
الجدير
ذكره، ماركس ليس هو واضع مصطلح "الطبقة الاجتماعية"، بل سبقه إليه علماء
ومفكرين كُثُر. فقد استُخدمه ماركس بمعاني غامضة ومختلفة.
المادية التاريخية (الديالكتيك):
يطلق
على النظرية الماركسية العديد من المسميات مثل: (نظرية الصراع، والمادية
التاريخية، والمادية الجدلية، والنظرية الشيوعية).
الجدير
ذكره، ماركس لم يستخدم مصطلحا (المادية الجدلية، والمادية التاريخية)، إنما عبر
عنهما بمصطلح واحد هو: (الديالكتيك). لكن التفريق بين المصطلحين من وضع شرّاح
الماركسية للتوضيح. وفيما يلي بيان الفرق بينهما:
أ. المادية الجدلية: يعد
هيجل هو مؤسس المادية الجدلية، استخدمها كمنهج وأسلوب للتحليل، والنقد، والتفكير.
فهي تهتم بالكشف عن القوانين التي تحكم تطور العالم المادي الذي من خلاله يمكن فهم
ودراسة الواقع الخارجي ككل.
ب. المادية التاريخية: تعد
الموضوع الأساسي للمادية الجدلية، تدور حول علاقة الوعي بالوجود، واعتبار المادة
أساس تشكيل الوعي. تعرفها الماركسية: "هي علم القوانين العامة التي تحكم تطور
المجتمع". تستخدم المادية التاريخية المنهج التحليلي النقدي الذي يعرف باسم
آخر (المادية الجدلية)، بهدف دراسة التطور الاجتماعي الشامل. فهي لا تقتصر على
دراسة تاريخ المجتمعات والشعوب، وتغير النظم الاجتماعية والاقتصادية، بل تهتم
بدراسة قوانين المجتمعات المعاصرة.
الأسس المنهجية للمادية التاريخية:
1.
استخدام
المنهج التاريخي التحليلي المقارن كمنهج مميز يساعد على فهم ودراسة الواقع
الاجتماعي بهدف التعرف على الخصائص المشتركة بين المجتمعات الإنسانية للاستعانة به
في فهم المستقبل.
2.
التأكيد
على ضرورة استخدام نوعين من القوانين عند تفسير الواقع الاجتماعي، هما:
v القوانين الاجتماعية العامة تحكم
التيارات الاجتماعية والاقتصادية.
v القوانين الخاصة تحكم كل بناء اجتماعي واقتصادي بمفرده.
عناصر المادية التاريخية:
1.
كل
المجتمعات الإنسانية مرت أو تمر في حالة من حالات الإنتاج الخمس، هي: (المشاعية
البدائية، الإقطاع، الرأسمالية، الاشتراكية، الشيوعية).
2. باستثناء نموذجا المشاعية البدائية،
والشيوعية. كل نموذج اعتمد في إنتاجه على التقسيم الطبقي. فكل مجتمع ينقسم إلى
طبقتين: الأولى: قلة يملكون وسائل الإنتاج. الثانية: أغلبية لا يملكون. تحاول الطبقة
الأولى جاهدة استغلال وسائل الإنتاج لتفرض سيطرتها على الطبقة الثانية.
الفرضيات التي تقوم عليها المادية التاريخية:
1.
تعتبر
الماركسية الصراع الطبقي قضية أزلية توجد في كل المجتمعات، فلا يخلو منها أي مجتمع
عبر التاريخ، باستثناء المرحلة البدائية.
2. تتحدد طبيعة البناء الطبقي من خلال نظام
الإنتاج.
3. النظام البرجوازي يحمل في ثناياه
تناقضات تؤدي إلى تدميره تلقائيًا وذاتيًا. حيث أن إنتاج السلع المختلفة سيقوم مع
مرور الزمن بإنتاج سلسلة من التوابع التي قد تسبب المزيد من البؤس، بالتالي يتم
اعتناق المزيد من المعتقدات الخاطئة، حينها سيدرك الناس حقيقة الماركسية. ومن خلال
التحصن بالحقيقة سيغير الأفراد المجتمع، ويشعرون بالحرية.
4. ستأخذ الطبقات العامة مبدأ المبادرة،
وتكتسب السيطرة السياسية.
5. سوف تتبنى طبقة العمال النظام الاشتراكي،
ثم تتحول إلى الشيوعية؛ لتحقيق أعلى درجات إنجاز الحرية الفردية.
الانتقادات التي وجهت إلى الماركسية:
1. اعتبرت العامل الاقتصادي هو العامل
الوحيد المفسر لعملية التغير الاجتماعي. في الواقع العامل الاقتصادي ما هو إلا
عامل في سلسلة عوامل مؤثرة في عملية التغير الاجتماعي.
2. تطور قوى الإنتاج يأتي نتيجة تقدم الفكر
الإنساني، والمعرفة الإنسانية.
3. لم توضح النظرية الماركسية الارتباطات
بين الأساس الاقتصادي للمجتمع، وبين البناء الفوقي.
4. الكثير من نبوءات ماركس لم تتحقق، مثل:
الصراع الطبقي، وانتصار البروليتاريا.
خامسًا: العامل الثقافي:
لا
توجد ثقافة إستاتيكية على الإطلاق، مهما كانت على درجة عالية من الحزم، والشدة،
والصرامة، والمحافظة، ومهما غلب عليها من القسوة، والعقاب، والردع. لابد أن يحدث
التغير الثقافي بأي درجة من الدرجات، وبأي شكل من الأشكال. هذا الاعتقاد خلاف
الاعتقاد الذي كان سائدًا لدى علماء الانثروبولوجيا في القرن التاسع العشر، حيث
كانوا يعتقدون أن ثقافة المجتمعات البدائية ثابتة.. جامدة.. لا تتغير. هذه النظرة
لم يكن يدعمها دراسات إمبريقية، إنما مجرد تصورات في أذهان أصحابها، إلى أن أجريت
دراسات إمبريقية أبطلت تلك النظرة، وأكدت ديناميكية الثقافة، وتغيرها. دلل على ذلك
الاكتشافات الأثرية.
إذن
التغير الثقافي شمل كل المجتمعات الإنسانية، لكن درجته، ومستواه تختلف من مجتمع
لآخر. مثلًا: التغير الثقافي في المجتمع الغربي المغرم بكل جديد أسرع من التغير القافي
في المجتمعات النامية.. التقليدية.. المحافظة. فيما يخص المجتمع العربي لم يعدم من
التغير الثقافي سواء في الجانب المادي أو غير المادي، أو الفكري. يمكن لمس ذلك بوضوح
في العادات، والتقاليد، والأفكار، واللباس، والطعام، والشراب، والزراعة، والصناعة،
والسكن، ووسائل الترويح، ودور العبادة... إلخ.
يرتبط
مفهوم التغير الثقافي بمفهوم "التعجيل الثقافي"، ويقصد به: "زيادة
معدل التغير الثقافي". وتحدث "أوجبرن" عن الهوة الثقافية بين
الثقافة المادية، وغير المادية، حيث أن الأولى أسرع تغيرًا، والأخرى بطيئة.
التغير
الثقافي ليس بمعزل عن ظواهر المجتمع الأخرى، لكن التغير الثقافي تختلف سرعته من
مجتمع لآخر. يقول العلماء: "كلما تعرض المجتمع لأزمة كانت درجة التغير
الثقافي أسرع".
التغير
الثقافي عملية انتقائية، فعندما يواجه أفراد المجتمع عادات، وتقاليد، وعناصر
ثقافية فإنهم يتقبلونها؛ لأنهم يعتبرونها مفيدة لهم، وتتوافق مع قيم مرغوب بها
اجتماعيًا. لذلك نجد ترحيبًا بالآلات الإلكترونية؛ لأنها مفيدة لهم، ولا تهدد
قيمهم الاجتماعية، بينما تحدث مقاومة للسلوكيات والأخلاقيات الأجنبية؛ لأنها تخالف
الأحكام الدينية، والقيم الاجتماعية، والأخلاق السائدة.
عندما
يتعرض المجتمع للتغير الثقافي فإنه يقبل من مجتمعات أخرى عناصر ثقافية معينة، ويرفض
أخرى، المحصلة النهائية، هي: خلق صيغة ثقافية جديدة تقوم على الدمج بين العناصر
الثقافية القديمة، والجديدة.
يشتمل
التغير الثقافي على مجموعة مفاهيم، مثل: التثاقف، والتفكك، والانحراف، والتطور،
والتغير التدريجي، والإبداع، والتكامل، والنقل، وإعادة الإحياء، وإعادة التفسير...
إلخ.
يعتبر التغير الثقافي أعم وأشمل من التغير الاجتماعي؛ لأن التغير الاجتماعي يشير إلى التحولات في النظم والوظائف الاجتماعية.
تعريف التغير الثقافي:
v "التحول الذي يتناول كل التغيرات
التي تحدث في أي فرع من فروع الثقافة، بما في ذلك الفنون، والعلوم، والفلسفة، كما
يشمل صور وقوانين التغير الاجتماعي، والتغيرات التي تحدث في قواعد النظام
الاجتماعي".
v
"التغيرات
التي تحدث في عنصر من عناصر الثقافة المادية أو غير المادية، بما في ذلك الفن،
والتكنولوجيا، والفلسفة، والأدب، واللغة، والأذواق العامة كالطعام، والشراب،
واللباس، ووسائل المواصلات".
خصائص التغير الثقافي:
1. التغير الثقافي عملية يترتب عليها
الكثير من المشكلات الاجتماعية.
2. التغير الثقافي يقوم على الاتصال الخارجي
مع المجتمعات الأخرى.
3. ينتج التغير الثقافي بشكل أساسي عن
الاختراعات، والاكتشافات، سواء كان الاختراع ماديًا، أو اجتماعيًا كظهور الديانات،
والفلسفات، والقوانين.
4. التغير الثقافي يطال فقط الجانب الثقافي
من المجتمع.
v إدوارد تايلور: "هي ذلك الكلّ
المركّب الذي يشتمل على المعرفة والعقائد، والفن والأخلاق والقانون، والعادات
وغيرها من القدرات التي يكتسبها الإنسان
بوصفه عضواً في المجتمع".
v قاموس لاروس الصغير: "مجموعة من
البنيات الدينية، والاجتماعية، والتظاهرات الثقافية، والفنية التي تميز مجتمعًا ما".
v "هي ذلك الكلّ المركّب الذي يتألف
من كلّ ما نفكّر فيه، أو نقوم بعمله أو نمتلكه، كأعضاء في مجتمع".
1.
إنسانية:
الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على ابتكار أفكار أعمال جديدة، فالإنسان انتقل من
مرحلة حضارية لأخرى، حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.
2. مكتسبة: يكتسب الإنسان الثقافة من
مجتمعه، عبر المراحل العمرية المختلفة، ومن مؤسسات التنشئة الاجتماعية المتنوعة.
3. اجتماعية: الثقافة نتاج اجتماعي.
4. تطوّرية: الثقافة ليست جامدة، بل
متطوّرة بتطوّر المجتمع.
5. استمرارية انتقالية: الثقافة لا تنحصر في مرحلة محدّدة، لذا لا تموت بموت الفرد، لأنّها ملك جماعي وتراث يرثه أفراد المجتمع جميعهم.
تؤثر
الثقافة على الفرد في النواحي التالية:
1) الناحية الجسمية: الثقافة السائدة لدى
شعب من الشعوب تجبر الفرد بما لها من قوّة جبرية على أعمال قد تضرّ بالناحية
الجسمية. مثلًا: كان من عادات بعض الطبقات المرفهّة في الصين ثني أصابع الطفلة،
وتطوى تحت القدم، وتلبس حذاء يساعد في إيقاف نموّ قدمها، ويجعلها تمشي مشية خاصة.
فعلى الرغم من التشوّه الذي يحصل للقدم، فقد كانت تلك المشية بالإضافة إلى صغر
القدم، من أهم دلائل الجمال.
2) الناحية العقلية: تؤثر الثقافة في عقلية
الأفراد، لاسيّما الجانب المعرفي. فالفرد الذي يعيش في جماعة تسود ثقافتها العقائد
الدينية أو الأفكار السحرية، تنشأ عقليته متأثّرة بذلك. فالمعتقدات التي تسود في
المجتمع الهندي، غير التي تسود في المجتمع الأمريكي أو العربي.
3) الناحية الانفعالية: تؤكّد الدراسات أنّ
للثقافة دورًا كبيرًا في تربية مزاج الشخص، وتهذيب انفعالاته. فكثيرًا ما نجد شخصًا
قد ورث عوامل تثير لديه الغضب، لكنّ التنشئة الاجتماعية الثقافية، ونبذ المجتمع
لتلك الصفة، يجعله يعدّل من سلوكه.
4) الناحية الخُلُقية: الأخلاق السائدة في
المجتمع، هي الحصيلة الناتجة من تفاعل القوى العقلية والانفعالية، مع عوامل البيئة.
أي النواحي الأخلاقية أكثر قربًا إلى العوامل البيئية، والوسط الاجتماعي، والثقافة
المهيمنة على الشخص. فلكلّ ثقافة نسق أخلاقي خاص ينساق فيه الفرد، متأثّرًا
بالمعايير الأخلاقية السائدة من ناحية الخير والشر، والصواب والخطأ، وما يجوز وما
لا يجوز، وإن كانت هذه المعايير نسبيّة تختلف في معانيها ودلالاتها من مجتمع لآخر.
فالجنوح عن تلك المعايير، أمر نسبي، فالسرقة مثلًا: تعد من الجرائم في المجتمعات
الحديثة، لكنّها كانت مباحة عند الشعوب البدائية، تعتبر نوعًا من البطولة.
صور تأثير
الثقافة على الأفراد:
1) تؤثر الثقافة في سلوك الفرد، وتفكيره، ومشاعره.
2) توفّر الثقافة للأفراد، تفسيرات جاهزة
عن الطبيعة، والكون، وأصل الإنسان، ودورة الحياة.
3) توفّر الثقافة للفرد المعايير التي
يستطيع أن يميّز بها بين الصواب والخطأ، والمقبول والمرفوض اجتماعيًا.
4) تنمّي الثقافة لدى الفرد الضمير، بحيث
يصبح الرقيب على سلوكه.
5) تنمّي الثقافة في الفرد الشعور
بالانتماء للجماعة والمجتمع، فتربطه بأفراد الجماعة شعور واحد، وتميّز جماعة عن
الجماعات الأخرى.
6) تكسب الثقافة الفرد الاتجاهات السليمة
لسلوكه، في إطار السلوك المعترف به من قبل الجماعة.
نظرية
الاتصال الثقافي:
تعريف التثاقف أو المثاقفة:
تعني
كلمة المثاقفة في علم الاجتماع الثقافي: "مختلف التحولات الثقافية التي تنتج
عن الاحتكاك الثقافي بين مختلف الثقافات الإنسانية، من حيث المقاومة، والاندماج،
والاضمحلال، والهيمنة". بمعنى آخر، المثاقفة: "هي عملية تبادل المعارف،
والمعلومات، والخبرات، والأفكار، والمشاعر، والممارسات، والنصوص بين الثقافات
والحضارات المنصهرة، والمتلاقحة، والمتفاعلة، والمتداخلة، والمتشابكة فيما بينها،
مع تبادل المنتجات الفكرية، والأدبية، والفنية، والقيم الرمزية بين الشعوب
المتجاورة أو المتباعدة، ضمن كون ثقافي واحد، عبر الاطلاع المعرفي، والاحتكاك
الثقافي، والترجمة، والاطلاع على آراء الآخرين، وتبادل الزيارات الثقافية من بلد
إلى آخر".
استخدم
مصطلح المثاقفة لأول مرة من قبل "جون ويسلي باول" سنة 1880م، في دراساته
حول المهاجرين القاطنين بأمريكا، في حين اختار الإنجليز مصطلح التبادل الثقافي، واختار
الفرنسيون مصطلح التداخل الثقافي.
في
أمريكا تعدّ "مارغريت ميد" الرائدة الأولى في تبنّي الاتجاه التواصلي
(التثاقف) في دراسة التغيير الاجتماعي الثقافي. فقد أجرت في مطلع ثلاثينات القرن العشرين
دراسة على الهنود الحمر في أمريكا، ومدى تأثّرهم بالمستعمرين البيض من خلال
احتكاكهم بهم، ولاحظت الاضطرابات التي حصلت في حياتهم الاجتماعية نتيجة لذلك. فقد
كان مجتمع الهنود الحمر في فترة الدراسة، يعيش حالة من الصراع الشديد، بين الأخذ
بالثقافة الجديدة الوافدة، وبين المحافظة على الثقافة القديمة التي اعتاد عليها،
لاسيّما أنّه لم يكن قد تكيّف بعد مع الأوضاع الجديدة. في المقابل، وجدت
المستعمرين البيض لم يهدفوا إلى التبادل بين الثقافتين، إنّما أرادوا للهنود الحمر
أن يندمجوا في ثقافتهم بصورة كاملة.
في
إنجلترا: دعمت دراسات "فيتز" فكرة النسبية الثقافية. لذلك، من الخطأ أن
تسعى الثقافة الغربية لإطلاق أحكام مسبقة على الثقافات الأخرى، وتتخذ من هذه
الأحكام مبررًا للممارسات الاستعمارية على أهل تلك الثقافات.
في
فرنسا: اتّخذ عددًا من الباحثين مواقف مشابهة لموقف فيتز في تبنّي مفهوم النسبية
الثقافية، ومناهضة النزعة الاستعمارية، التي تنظر إلى التثاقف أنّه عملية تقوم على
السيطرة، ورفضوا الفوارق الثقافية، والاستعلاء الغربي على الشعوب الأخرى.
ظهر
في النصف الثاني من القرن العشرين عددًا من الانثروبولوجيين الذين بدأوا يضعون
نظرية خاصة لدراسة المجتمعات الإنسانية ومراحل تطوّرها، وموقع التغيير الثقافي في
ذلك. كان من أبرز هؤلاء: (تشايلد، وستيوارد، وهوايت). فقد دعا "هوايت"
لعدم استخدام النظم الأوروبية كأساس لقياس التطور، ويجب إيجاد محكات أخرى يمكن
قياسها. وأكّد على ضرورة ألا تقتصر النظرية التطوريّة على تحديد مراحل النمو
الثقافي، فلابد من إبراز العوامل التي تحدد هذا التطور. ويمثّل العامل التكنولوجي المحك
الرئيس لتقدّم الشعوب. أي المضمون التكنولوجي في ثقافة ما يحدّد كيانها الاجتماعي
واتّجاهاتها الأيديولوجية.
انقسم
الاتّجاه الثقافي التطوّري، إلى ثلاث مدارس تنادي كلّ منها بمجموعة من القضايا
العامة:
·
المدرسة
الأولى: تأخذ بمسلمة "التاريخ يتجه في تتابع وحيد حين تتطوّر النظم
والعقائد"، استنادًا لمبدأ الوحدة السيكولوجية للبشر. من هنا تتطوّر الثقافة
الإنسانية، حيث تتشابه الظروف العقلية والتاريخيّة.
·
المدرسة
الثانية: تأخذ بالمنهج المقارن لعقد مقارنات بين الشعوب والثقافات في سائر المراحل
المبكرة لأطوار الثقافة، بحثًا عن مصادر السمات الثقافية.
·
المدرسة
الثالثة: تأخذ بفكرة الرواسب الثقافية، على اعتبار أنّ هذه الرواسب القائمة في
المجتمع هي شواهد من الناحية المنطقيّة، وأنّ المجتمع قد مرّ في مراحل أقلّ تطوّرًا
ومراحل أكثر تركيبًا وتطوّرًا.
مهّدت أفكار التطوّرية الجديدة لنشوء تخصّص يبحث في العلاقات المتبادلة بين الطبيعية والثقافة، عرف باسم "الأيكولوجيا الثقافية"، يعتمد في تفسير تباين ثقافات الشعوب على ظاهرة التنوّع البيئي، ويهتم بالكشف عن كيفيّة تأثير الثقافة مع ما يحدث في البيئة من تغيرات جذرية، على تكيّف الفرد وتفاعله الاجتماعي. تتلخّص وجهة نظرهم هذه في جملة (التأثير القوي للبيئة، وأنّ أثر البيئة كبير على الثقافة في مجالات كثيرة). يستشهدون على ذلك، بسكان الأسكيمو، واستراليا الأصليين، وتأثّر ثقافة هذه الشعوب بالبيئة المحيطة. لكنّ ثمّة معارضون في العصر الحديث لهذه النظرية؛ لأنّهم يرون أنّ كثيراً من البيئات المتشابهة، تضمّ ثقافات وحضارات مختلفة.
تبلورت
النظرية المعرفية في الدراسات الانثروبولوجية في ستينات القرن العشرين، من خلال
مدرستين رئيسيتين، هما:
1. المدرسة البنائية:
يعد شتراوس مؤسّس المدرسة البنائية في
الدراسات الثقافية الانثروبولوجية. يأخذ مفهوم البناء عنده طابع النسق، حيث يتكون من
مجموعة عناصر، يمكن لأي تحوّل في أحدها أن يحدث تحولًا ما في العناصر الأخرى. وسعى
للربط بين الدراسات اللغوية، والاجتماعية، والأثنولوجية. مبينًا أن العلاقات
الاجتماعية في أي نظام اجتماعي لا يمكن أن تفهم إلاّ في إطار عملية التواصل
والتبادل بين الأفراد الذين يشكّلون هذا النظام الاجتماعي.
2. المدرسة الأثنوجرافية الجديدة:
ظهرت في أمريكا في مطلع ستينات القرن العشرين،
تستند هذه النظرية إلى نتائج علم اللغة، والعلاقة المتبادلة بين علم اللغة
والأثنولوجيا، والاستفادة من هذين العلمين في تبنّي منهج متكامل للبحث في العلوم
الاجتماعية.
برز اهتمام الأمريكان بالصلة بين اللغة والثقافة منذ عام 1964 حين اقترح "هايمز" مصطلح (الأنثروبولوجيا اللغوية). انطلاقًا من هذا المصطلح، بدأ الانثروبولوجيون اللغويون المعاصرون يهتمون بتطوير المدخل اللغوي في دراسة الثقافة. لذلك قام عدد من الانثروبولوجيين الأمريكان، بإجراء دراسات لغوية بقصد تأكيد علمية دراسة الثقافة الإنسانية من خلال وصف الثقافة وتحليلها وفقاً لتصوّرات الأفراد ومفاهيمهم، التي تتجلّى في سلوكهم اللغوي.
المراجع:
1.
بسام
محمد أبو عليان، محاضرات في علم اجتماع السكان، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2017.
2. بسام محمد أبو عليان، محاضرات في علم
اجتماع المعرفة، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2015.
3. جميل حمداوي، الثقافة مفاهيم ومقاربات
نحو رؤية سوسيو-انثروبولوجية، شبكة الألوكة، www.ukah.net
4. دلال ملحس استيتية، التغير الاجتماعي
والثقافي، ط2، عمان، دار وائل للنشر، 2008.
5. عيسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان، دمشق،
اتحاد الكتاب العرب، 2004.
6. مجهول المؤلف، الأيكولوجيا الاجتماعية،
موقع مقاتل من الصحراء، د.ت، http://www.moqatil.com/
7.
محمد
الدقس، التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق، ط2، عمان، مكتبة مجدلاوي، 1996.
8. ويكبيديا (الموسوعة الحرة)، علم البيئة
البشرية، 8/7/2021، https://ar.wikipedia.org/
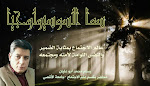
تعليقات
إرسال تعليق