 |
| د. بسام محمد أبو عليان قسم علم الاجتماع - جامعة الأقصى |
مراحل تطور الجماعة:
أهمية
دراسة تطور الجماعة:
على
الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل مع الجماعات فهم ودراسة التغيرات التي تطرأ على
الجماعة، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط الآتية:
(1)
لكل
مرحلة من مراحل تطور الجماعة خصائصها التي تؤثر على الأعضاء، مما يلزم الأخصائي
الاجتماعي بضرورة فهم تلك الخصائص؛ حتى يتمكن من توجيه التفاعل بطريقة إيجابية
وفعالة.
(2)
الالتزام
بمبدأ الفردية، مما يعني مراعاة الفروق الفردية بين الجماعات من جهة، ومراعاة
الفروق الفردية بين أعضاء الجماعة الواحدة من جهة أخرى.
(3)
فهم
مرحلة تطور الجماعة يسهِّل عليه الانتقال إلى المرحلة التالية بشكل مرن.
(4)
إدراك
الخصائص البنائية والوظيفية للجماعة في كل مرحلة من مراحلها، فهذا يساعده عند وضع
خطة المساعدة.
(5)
معرفة
طبيعة التغيرات التي تطرأ على الجماعة يمني عنده المهارات المهنية، لاسيما مهارة
الملاحظة، فهذه مهمة في عملية التقييم.
(6)
يعتمد
فهم الأخصائي الاجتماعي لطبيعة الجماعة من خلال فهمه لطبيعة العلاقات الاجتماعية
داخلها.
(7)
فهم
احتياجات أعضاء الجماعة مرتبط بمدى فهمه لمراحل تطور الجماعة.
(8)
وضع
نموذج لمراحل تطور الجماعة يساعده على التنبؤ بما يمكن أن يحدث في كل مرحلة من
مراحل تطور الجماعة، واحتياجات الأعضاء في كل مرحلة.
سنعرض
فيما يلي مراحل تطور الجماعة:
1.
مرحلة ما قبل الجماعة:
تنقسم
هذه المرحلة إلى ثلاث محطات، هي:
أ- المرحلة الخاصة: تكون الجماعة مجرد فكرة
تدور في ذهن فرد أو مؤسسة، ويرشح بعض الأفراد لتكوين الجماعة، من أجل تحقيق أهداف
محددة، حيث يتم البحث عن أعضاء يمتلكون مهارات قيادية وإدارية. يكون الاهتمام
منصبًا على عنصر التشابه والتوافق بين الأعضاء.
ب- المرحلة العامة: يتم تعريف الأفراد
الآخرين من غير المؤسسين بفكرة الجماعة، ويدعون لحضور اجتماع تعريفي للتعرف على كل
التفاصيل المتعلقة بالجماعة.
ج- مرحلة التجمع: يلتقي الأفراد الراغبين
بالانضمام إلى الجماعة، للتعبير عما يدور في أذهانهم وتوقعاتهم بالنسبة لبعضهم
البعض، وبالنسبة للجماعة. يتميز الانضمام إلى الجماعة ببعض الطقوس الاحتفالية
ككلمة ترحيب تبين أن العلاقة قد تغيرت بين الجماعة والعضو الجديد.
2. مرحلة
بدء عمل الجماعة:
بعد
انضمام العضو إلى الجماعة تبدأ مرحلة التنشئة، حيث يتعلم العضو معايير الجماعة
التي تحدد القواعد السلوكية المقبولة والمرفوضة في سياق الجماعة.
أعضاء
الجماعة ليسوا سواء، منهم من يتعلم تلك المعايير ويلتزم بها ليكون عضوًا فعالًا
ومميزًا في الجماعة، ويعرف مكانته ودوره في الجماعة، ومنهم من يؤثر في طريقة عمل
الجماعة؛ لتشبع حاجاته بالشكل الأمثل، كأن يغير معايير الجماعة، أو يغير الأنشطة.
في
هذه المرحلة يتم:
· اختيار القادة.
· وضع أهداف الجماعة.
· وضع برامج الجماعة.
· تحديد قواعد قبول الأعضاء الجدد.
3.
مرحلة الإعداد:
في
هذه المرحلة تبدأ الجماعة تتفهم مهمتها. هذا متوقف على عدة عوامل، هي:
· القيادة.
· الولاء للجماعة.
· قدرات واستعدادات أعضاء الجماعة.
4.
مرحلة جمع المعلومات:
في
هذه المرحلة يتم جمع المعلومات
المطلوبة لفهم المشكلات، والعمل على حلها.
5.
مرحلة البدائل والاختيارات:
في
هذه المرحلة تتبلور أفكار الجماعة، وتحدد المهام المطلوبة، والموارد المتاحة، وهذا
يستغرق وقتا طويلا إذا كانت المشكلات متشعبة.
6.
مرحلة اتخاذ القرار:
في
هذه المرحلة توافق الجماعة على الخطة، والبرامج، وأسلوب حل المشكلات.
7.
مرحلة إعداد التقارير:
يكلف
الأعضاء بإعداد أجزاء من التقارير النهائية، ويقدمونها للجماعة، ويجب أن تؤخذ هذه
التقارير في الاعتبار.
وقد
ميز تاكمان بين خمس مراحل لتطور الجماعة، هي:
1.
التكوين:
يتعرف أعضاء الجماعة على بعضهم البعض، ويسيطر عليهم الشك بدرجة كبيرة؛ لأنهم لا
يعرفون بعضهم جيدًا.
2. العصف:
يقاوم أعضاء الجماعة التأثير، وعدم الاتفاق، ونشوء صراعات بدرجات عالية.
3. تكوين
المعايير: يشترك أعضاء الجماعة في أهداف مشترك، وتنشأ بينهم علاقة صداقة وتماسك بدرجة
كبيرة.
4. الأداء:
يعمل أعضاء الجماعة معًا لتحقيق هدف الجماعة، والوصول لمستوى اداء أفضل.
5. النهاية:
يترك الأعضاء الجماعة، ويتملكهم شعور الإنجاز أو الفشل.
نظام لبالز لترميز
العلاقات الاجتماعية داخل الجماعة:
|
م |
نمط السلوك |
الترميز |
|
1 |
انفعالي إيجابي |
1.
يبدي التضامن، ويرفع مكانة الآخرين،
ويقدم المساعدة، والمكافئة. 2.
يبدي خفض التوتر، والدعابة، والضحك،
وإظهار الرضا. 3.
الاتفاق، وإظهار المواقفة السلبية،
والفهم، والتوافق، والإذعان. |
|
2 |
محايد |
1.
يقدم الاقتراحات، والتوجيهات، ويهتم
باستقلالية الآخرين. 2.
يبدي الرأي، ويقيم، ويحلل، ويعبر عن
المشاعر والأمنيات. 3.
يعطي التوجيهات والمعلومات، ويكرر،
ويوضح، ويؤكد. 4.
يطلب التوجيه والمعلومات، والتكرار،
والتأكيد. 5.
يسأل عن الرأي، والتقييم، والتحليل،
والتعبير عن المشاعر. 6.
يطلب الاقتراحات والتوجيه، وطرق ممكنة
للعمل. |
|
3 |
انفعالي سلبي |
1.
يختلف، يظهر الرفض السلبي، والرسمية،
ويحجب المساعدة. 2.
يبدي التوتر، ويطلب المساعدة، وينسحب
من المجال. 3.
يبدي العداء، ويقلل من مكانة الآخرين،
ويدافع عن النفس أو يؤكدها. |
الأدوار في الجماعة:
1) أدوار وظيفية:
الباحث عن المعلومات، والمدلي بالمعلومات، الموضح، الملخص، المنسق، الناقد، المسجل.
2) أدوار بنائية:
المشجع، الموفق، الملاحظ، المسهل، صاحب المثل العليا، التابع.
3) أدوار فردية:
المبتكر، المستفسر، النظري، العملي، المعبر، المنظم، الإجرائي، المقيّم.
رصد
الباحثون الذين عملوا مع الجماعات الأدوار التي تبناها الأعضاء:
1. رفض الأفكار والمقترحات لمجرد الرفض.
2. تأييد الأفكار والمقترحات لمجرد
التأييد.
3. التوفيق بين المواقف المتعارضة.
4. الابتعاد عن التدخل في المناقشة.
5. أعضاء يقومون بفحص الحقائق والمعلومات.
6. أعضاء يوضحون ما تواجهه الجماعة من
مشكلات من خلال خبراتهم السابقة.
7. أعضاء يقومون بالاستفسار، وجمع المعلومات
اللازمة.
8. أعضاء يتطوعون بتقديم الحلول
والاقتراحات.
9. أعضاء يقومون بتذكير الجماعة بأهدافها،
وتحديد المشكلات.
10. أعضاء
لا يساهمون مساهمة فعالة في برامج وأنشطة الجماعة.
11. أعضاء
يصرون على التمسك بآرائهم، ويقومون بتنفيذها بطريقة ما.
أساليب العمل مع
الجماعة:
يختلف
أسلوب العمل مع الجماعات
وفقًا للنماذج الآتية:
أولًا| نموذج الأهداف الاجتماعية:
تنشأ
الجماعة لتخدم أهداف اجتماعية للمجتمع الذي توجد فيه. فتظهر الجماعة بعد ظهور
مشكلات في المجتمع، وتستخدم الجماعة كوسيلة لعلاج ومواجهة المشكلات من خلال
برامجها، وأنشطتها. وتستخدم عدة أساليب أهمها:
¬ وضوح سياسة المؤسسة وأهدافها.
¬ الاستخدام الأمثل للإمكانيات.
¬ تحديد البرامج والأنشطة اللازمة للعمل.
¬ تحديد أولويات العمل وفقًا لأهميتها.
ثانيًا| النموذج العلاجي:
يركز
النموذج العلاجي على الجماعة باعتبارها أداة للتغيير، وعلى الأخصائي دعم التفاعل
بين أعضاء الجماعة؛ ليتحقق التغير المنشود.
يتميز
النموذج العلاجي بالواقعية في مواجهة مشكلات عدم التكيف في الجماعة، وعلاج مشكلات
العلاقات الاجتماعية للفرد.
يستخدم
النموذج العلاجي بشكل كبير في مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، ومراكز الإصلاح
والتأهيل الاجتماعي للأحداث والكبار، ومراكز رعاية الأسرة، والمدارس، وغيرها من
المؤسسات.
ثالثًا| نموذج التفاعل التبادلي:
يخدم
نموذج التفاعل التبادلي الفرد والمجتمع معًا. فالفرد يمكن دراسته، وفهمه، ومعاملته
وفقًا للنظم الاجتماعية التي يعتبر جزءًا منها.
يرى
النموذج التفاعلي التبادلي أن الفرد يؤثر ويتأثر بعلاقاته الاجتماعية، وبمؤسسات
المجتمع. في هذه الحالة تشكل الجماعة إطارًا تتم فيه العلاقات الاجتماعية وعمليات
التأثير والتأثر لتحقيق نمو الفرد، وزيادة وعيه بالآخرين، وتنمية قدراته بناءً على
علاقات اجتماعية سليمة.
رابعًا| النموذج التنموي:
يركز
النموذج التنموي على أداء الفرد الاجتماعي باستثارة قدراته الكامنة، وتوظيف طاقاته
لتحقيق أعلى درجة من فهمه لذاته، وفهم الآخرين الذين يتفاعل معهم، والإحساس
بالمواقف الاجتماعية، والمساهمة في برامج العمل الجماعي التي تخدم المجتمع المحلي.
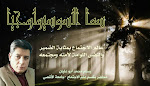
تعليقات
إرسال تعليق