 |
| د. بسام أبو عليان محاضر بقسم علم الاجتماع - جامعة الأقصى |
معايير تكوين الجماعة:
تتكون الجماعة بناءً على معيارين، هما:
(1)
المعيار
الكمي: تكوين جماعات متساوية من حيث العدد، يتراوح عدد أعضائها بين عضوين إلى ستة
أعضاء، والعدد المناسب خمسة أعضاء، والعدد الأقصى ألا يتجاوز خمسة عشر عضوًا.
(2)
المعيار
الكيفي: يقصد به معيار التجانس بين أعضاء الجماعة، أي تتكون الجماعة من أفراد
يشتركون في معايير محددة، مثل: العمر، النوع، البيئة الاجتماعية، الحالة
الاجتماعية، المستوى التعليمي، المهنة... إلخ.
الجماعات الصغيرة:
حدد جون كندي أساسيات الجماعة الصغيرة، وهي:
1.
محدودية
عدد أعضائها، بحيث يسمح للأعضاء التعرف على بعضهم، ويتفاعلون مع بعضهم البعض.
2.
لهم
أهداف متبادلة. نجاح أي هدف يؤثر على نجاح الأهداف الأخرى.
3.
كل
عضو يشعر بالانتماء للجماعة.
4.
يوجد
حوار لفظي بين الأعضاء؛ يشجع على قيام مناقشة جماعية تؤثر على سلوك وأفكار الأعضاء.
5.
للجماعة
قواعد سلوكية مستوحاة من ثقافة المجتمع، وتحظى بقبول الأعضاء.
خصائص تكوين
الجماعة الصغيرة:
حدد
محمود حسن خصائص تكوين الجماعة الصغيرة في النقاط الآتية:
1. الدوافع المشتركة تؤدي إلى التفاعل.
2. أثناء التفاعل تظهر دوافع جديدة.
3. آثار التفاعل تنعكس على كل أعضاء
الجماعة.
4. تكوين بناء الجماعة.
5. تحديد معايير الجماعة.
أهمية دراسة
الجماعة الصغيرة:
1. الجماعة الصغيرة مصدر لإشباع حاجات
الفرد، وتتيح المجال لاكتشاف المشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها.
2. الجماعة الصغيرة مجال خصب للملاحظة،
والتجربة.
3. عن طريق دراسة الجماعات الصغيرة يمكن
الوصول إلى تعميمات لعدد من الأنساق الاجتماعية الجزئية التي يتكون منها البناء
الاجتماعي.
4. تعتبر الجماعات الصغيرة حالات خاصة تمثل
النسق العام.
الجماعة كنسق اجتماعي:
1. أجزاء الجماعة لها علاقة بالكل.
2. تتشابه أجزاء النسق في بداية الظهور،
لكن مع التطور والنمو يحدث تباين بين الأجزاء؛ بسبب التخصص، وزيادة عدد الوحدات.
3. يتطور النسق بصورة كلية.
4. أفعال النسق تصدر نتيجة وجود خلل، وهي
تهدف إلى إعادة التوازن.
5. إذا حدث فعل معين، فإن الكل يستجيب لهذا
الفعل.
مفاهيم تحليل
النسق:
1. النشاط:
هو ما يفعله أعضاء الجماعة.
2. التفاعل:
هو العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين أعضاء الجماعة فقد تكون على شكل تعاون، أو صراع،
أو تنافس، أو عدم مشاركة.
3. العاطفة:
هي مجموع المشاعر التي تسود بين أعضاء الجماعة، (الحب، الكره، الفرح، الحزن،
السعادة، التشاؤم... إلخ).
4. المعايير:
هي قواعد ومحددات السلوك التي تتبناها الجماعة، وتبين المرغوب فيه والمرفوض داخل
الجماعة.
فرضيات الجماعة
كنسق اجتماعي:
1- الجماعة نسق اجتماعي لا يمكن فهم أعضاؤها
إلا في إطار علاقاتهم التكاملية.
2- يتم التعاون بين أعضاء الجماعة؛ نتيجة
التعايش فيما بينهم.
3- تأثير العضو في الجماعة محدود، لكن
تأثير الجماعة في العضو أعمق.
4- ضرورة انفتاح الجماعة حتى تقوم
بوظائفها.
5- دور أخصائي الجماعة مساعدة الجماعة
للتغلب على مشكلاتهما.
تأثير الجماعة على
الأفراد:
1- تتيح الجماعة للأفراد فرص النمو السليم،
والتفاعل والتعليم السوي.
2- خصائص الفرد الاجتماعية مكتسبة، وقابلة
للتغير من خلال التفاعل الاجتماعي.
3- للجماعة قدرة للتأثير على عادات،
وتقاليد، وقيم، ومعتقدات الفرد.
4- يستطيع الفرد إدراك ذاته من خلال
التفاعل مع الجماعة.
5- الخبرات لها دور في التأثير على أفراد
الجماعة من خلال الأنشطة الترويحية، وتعطي الفرد فرصة لتعلم واكتساب قيم واتجاهات
جديدة.
6- تنمِّي الجماعة شخصية الأفراد، وتكوين
اتجاهاتهم.
7- تساعد الجماعة الأفراد على ترجمة
أهدافهم الفردية وتحويلها لأهداف جماعية.
8- الجماعة تمنح الفرد فرصة للإبداع، والابتكار،
والقيادة، والتعبير عن أفكاره.
الخصائص البنائية
للجماعة:
أ- تنشأ
الجماعة من حاجة أعضائها إلى الكفاءة، والتخصص، والانتظام.
ب- تنشأ الجماعة من الدوافع والقدرات
الموجودة عند الأفراد.
ج- تنشأ الجماعة من خلال الخصائص المادية
والاجتماعية للبيئة التي توجد فيها الجماعة مثل: التاريخ، والأدوات، والمناخ.
المفاهيم المرتبطة
بالبناء الاجتماعي للجماعة:
1. جاذبية الجماعة.
2. تكوين الجماعة.
3. التفاعل الجماعي.
فيما يلي الحديث عن
هذه المفاهيم:
أولًا| جاذبية الجماعة:
عوامل جاذبية العضو
للجماعة:
1) أهداف الجماعة، وبرامجها، وأنشطتها، وحجمها، ومكانتها في
المجتمع.
2) دوافع العضو واحتياجاته، كاحتياجه للأمن،
الحماية.
3) جاذبية الأعضاء لبعضهم البعض وفق معايير
السن، النوع، البيئة الاجتماعية، المستوى التعليمي، المستوى الاقتصادي... إلخ.
4) يشبع الفرد حاجاته خارج الجماعة عن طريق
وسائل يتعلمها من الجماعة.
أساسيات جاذبية الجماعة:
1) تكوين صداقات جديدة.
2) اكتساب قيم ومعايير جديدة، التي هي في
الأصل قيم ومعايير الجماعة.
3) تعلم السلوك الاجتماعي المناسب.
4) تعلم الفرد الكثير عن نفسه، وعن زملائه.
5) يجد الفرد المتعة والرضا عن عمله في
الجماعة.
6) تنمو لدى الفرد مهارات الاتصال والتواصل.
7) تنمو لدى الفرد القدرة على حل المشكلات
التي تواجهه في حياته اليومية.
8) يستمد الفرد من الجماعة الأمن
والاطمئنان.
انضمام
الفرد للجماعة هدفه الأساسي إشباع حاجاته، بالتالي يمكنه الانسحاب من الجماعة ما
لم تشبع حاجاته. كأن تخفض مكانته الاجتماعية داخل الجماعة، أو تمارس عليه ضغوطًا
من أجل ترك الجماعة، أو لم تعد الجماعة تقدم له شيئًا يفيده.
الخروج
من الجماعة والالتحاق بأخرى يختلف باختلاف نوع الجماعة. هناك جماعة يمكن للفرد الانسحاب
منها بمشيئته، وجماعة أخرى تفرض على الفرد قيودًا؛ لئلا يتركها. كثيرًا ما توضع
القيود عند قبول العضو الجديد.
تتبع
الجماعات الرسمية وغير الرسمية لوائح محددة في قبول العضو الجديد، لكن الجماعات
غير الرسمية لوائحها أشد.
ثانيًا| تكوين الجماعة:
مبادئ تكوين الجماعة:
1) عدم إهمال أثر عدوى السلوك، فإذا وضع
الفرد في جماعة لا تناسب عمره أو لا توافق اهتماماته وميوله، في هذه الحالة سيصبح
هذا الفرد مصدرًا للشغب والإزعاج داخل الجماعة؛ كون المناخ الاجتماعي للجماعة لا
يناسبه.
2) عدم المبالغة في الخشية من عدوى السلوك،
فأخصائي الجماعة يتملك مهارات تمكنه من دمج احتياجات هذا العضو مع احتياجات
الجماعة.
3) أن يوضع في الاعتبار عند تكوين الجماعة
أن سلوك العضو قد لا يتماشى مع سلوك الجماعة، مما يؤدي إلى صدمة هذا العضو.
الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تكوين الجماعة:
v أن تتكون الجماعة من أفراد لهم مشكلات
مشتركة.
v أن تكون هناك مزاوجة بين الأعضاء؛ حتى
يستطيعوا التوحد مع الآخرين، مع الاحتفاظ بعنصر الاختلاف.
v أن يكون الأعضاء متقاربين في الخصائص
والسمات الشخصية.
الحاجات النفسية التي تشبعها الجماعة:
(1) الحاجة إلى الانتماء:
لا يختلف اثنان بأن الإنسان كائن اجتماعي، لا يستطيع العيش بمعزل عن الآخرين، لذلك
يسعى دائمًا للارتباط بجماعة معينة؛ من أجل خفض التوترات الناجمة عن العزلة، وتعينه
الجماعة على إشباع حاجاته المختلفة.
(2) التجاذب بين الأعضاء:
محددات التجاذب كثيرة ومتنوعة، منها: التقارب المكاني، وتشابه الملامح، والسمات
الشخصية، والقدرات العقلية، والميول والاهتمامات، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، والثقافي
والتعليمي.
(3) جاذبية أهداف وأنشطة الجماعة:
لا يخرج تكوين الجماعة عن هذه الثوابت:
· الهدف:
أن يكون للجماعة هدف مشترك يسعى الأعضاء إلى تحقيقه في وقت أقصر، ودافعية أكبر.
· الحجم:
سبق أن وضحنا عدد الجماعة المناسب حسب هدف تشكيلها، لذلك بدون أفراد لا يمكن أن تكون
الجماعة أصلًا.
· التفاعل والعلاقات: لا يمكن أن
يكتب للجماعة الاستمرار ما لم يوجد تفاعل وتنشأ علاقات بين أفرادها قوامها الحب، والتقبل،
والانفتاح.
نماذج تكوين الجماعات كما حددتها مارجريت
هارتفورد:
(1) عضوية بناءً على اختيار العضو. كأن
يختار الفرد الانضمام لجماعة كرة القدم، أو كرة السلة، أو كرة الطائرة.
(2) اختيار العضو بواسطة الجماعة وفق معايير
محددة. كجماعة الخطابة لا تسمح بالانضمام إليها إلا من يملك مهارات الخطابة، ولديه
ثروة لغوية، ومحب للقراءة، وعدم الرهبة من الجمهور... إلخ.
(3) تكوين الجماعة بناءً على حاجات محددة،
أو مشكلات خاصة. كجماعة المعاقين بصريًا، أو المعاقين سمعيًا، أو المطلقات، أو
الأرامل، أو الأيتام... إلخ.
(4) تكوين الجماعة وفق معايير مؤسسية.
كجماعة الكشافة المدرسية، أو اللجان المدرسية.
لمعالجة مشكلة عدم التجانس
بين أعضاء الجماعة على أخصائي الجماعة إتباع الخطوات الآتية:
v عقد مقابلات مع الأفراد الذين يعانون من
عدم التجانس مع الجماعة؛ للتعرف على مشكلاتهم، ووضع حل لها.
v أن تتسم البرامج بالمرونة، لإشباع حاجات
الأفراد غير المتجانسين.
v مرونة نظام عمل المؤسسة؛ ليتلاءم غير
المتجانسين مع نظام المؤسسة.
v إلحاق الأعضاء غير المتجانسين مع جماعات
أخرى أكثر تجانسًا.
ثالثًا| التفاعل الجماعي:
تعريف التفاعل الجماعي:
"هو
مجموعة المثيرات والاستجابات التي تحدث داخل الجماعة، وتفاعل هذه السلوكيات مع
المواقف التي تمر بها الجماعة".
أهمية التفاعل الجماعي:
(1) اكتشاف حاجات، ورغبات، وقدرات أعضاء الجماعة.
(2) التعرف على مراحل النمو وسلوك أعضاء
الجماعة، ومدى تقبلهم لأخصائي الجماعة، وبرنامج الجماعة.
(3) الوقوف على مشكلات أعضاء الجماعة، ومدى
قدرتهم على مواجهتها وحلها.
(4) إكساب أعضاء الجماعة قيم ومعايير
وسلوكيات جديدة.
العوامل المؤثرة في التفاعل الجماعي:
(1) يتأثر
التفاعل داخل الجماعة بعدة عوامل، مثل: السن، والجنس، والمستوى التعليمي، والحالة الاقتصادية،
والمركز الاجتماعي، والقدرات العقلية، والتجارب الاجتماعية، والبيئة الاجتماعية.
(2) ما يمتلكه أعضاء الجماعة من قدرات وميول
ورغبات تؤثر في نوعية العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجماعة، واختيار الصداقات.
(3) نوعية القيادة في الجماعة (ديمقراطية، أو
تسلطية).
(4) شعور الأفراد بالولاء والانتماء
للجماعة.
(5) قيم الجماعة تمثل إطارًا عامًا للأنشطة،
ويجب أن تكون مستوحاة قيم المجتمع.
(6) النمو المهني لأخصائي الجماعة.
(7) النظام الداخلي للجماعة (اللوائح، والأنظمة).
(8) النظم الاجتماعية السائدة في المجتمع:
(العادات، التقاليد، القيم، المعتقدات).
(9) الظروف الطبيعية (زمان، مناخ، مكان).
(10) الظروف
المجتمعية (صراع، استقرار).
دور أخصائي الجماعة في عملية التفاعل
الجماعي:
1) التفاعل شرط لبقاء واستمرار الجماعة.
2) الفهم الصحيح لعملية التفاعل الاجتماعي.
3) توجيه التفاعل داخل الجماعة نحو تحقيق
الأهداف المنشودة من تكوين الجماعة.
4) من خلال التفاعل يمكن الوصول إلى مستوى
مقبول عن الحياة الاجتماعية.
5) التفاعل مظهر من مظاهر الحياة
الاجتماعية.
6) التفاعل يشمل بعض أو كل أعضاء الجماعة،
وكلما زادت رقعته زاد تأثيره.
7) ملاحظة دور العضو في الجماعة، والبناء
الاجتماعي للجماعة، وخريطة العلاقات الاجتماعية.
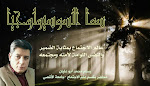
تعليقات
إرسال تعليق