 |
| د. بسام أبو عليان قسم علم الاجتماع - جامعة الأقصى |
آليات التغير الاجتماعي:
1.
الاختراع:
الاختراع هو ابتكار
أشياء جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل: اختراع شبكة الإنترنت، والأقمار الصناعية،
والتكنولوجيا الطبية... إلخ. أو إعادة تحسين مخترعات قديمة، كتحسين صناعة السيارات،
والطائرات، والحاسوب... إلخ.
تؤثر الاختراعات على البناء الاجتماعي والثقافي، فتؤدي إلى تغيرات اجتماعية وثقافية. لذا اعتبر "جورج ميردوك" الاختراعات هي أساس التغير الثقافي في المجتمع، فحين تخترع فكرة أو آلة ما فإنها تنتقل من شخص لآخر، وتنتشر في المجتمع، وتبدأ التغيرات التكيفية بعد ذلك، ويستغرق ذلك وقتًا، ولن يؤخذ بالاختراع الجديد إلا بعد إثبات كفاءته.
2.
الاكتشاف:
يقصد بالاكتشاف اكتشاف
عناصر جديدة في الطبيعة، كاكتشاف القارة الأمريكية، وطريق رأس الرجاء الصالح. أو
وضع قوانين جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل قوانين منع أو ضبط الزواج المبكر،
وتعدد الزوجات، وقوانين تنظيم النسل. كل هذه الاكتشافات والقوانين تسهم في إحداث
تغير اجتماعي.
3.
الذكاء والبيئة الثقافية:
ليس بإمكان أي فرد أن
يكون مخترعًا أو مكتشفًا، فهذه تتطلب مستوى عاليًا من الذكاء، وهذا ليس متوفرًا
لدى كل أفراد المجتمع. ويرى علماء النفس أن الذكاء قد يكون وراثيًا أو مكتسبًا.
الذكاء هو الذي يقود
إلى الاختراع. لكن لن يكتب للفرد الذكي النجاح ما لم تكن البيئة الثقافية
والاجتماعية المحيطة به تساعده على الاكتشاف والاختراع.
4.
الانتشار:
الاختراعات لن تنجح ما
لم يكتب لها الذيوع، والانتشار بين الناس، فمع انتشارها تؤدي إلى تغيرات اجتماعية.
انتشار الاختراع يعني أنه حظي بالقبول الاجتماعي، بالتالي الاختراع الذي لم يحظَ
بالقبول الاجتماعي لن يكتب له الانتشار. لكن قبول الاختراع لا يأتي فجأة، ولا يكون
سريعًا، إنما يحتاج إلى مراحل تدريجية، وتختلف هذه المراحل بحسب ثقافة المجتمعات
وتطورها. قد يكون قبول الاختراع بشكل طوعي أو فرضي.
ميز
علماء الاجتماع والانثروبولوجيا بين ثلاث عمليات منفصلة للانتشار، هي:
أ. الانتشار الأولي: يحدث من خلال الهجرة، كالتغير
في الثقافة الأمريكية؛ بسبب هجرة أعداد كبيرة من الأفراد إلى أمريكا مطلع القرن
العشرين.
ب. الانتشار الثانوي: يشمل عملية النقل
المباشر لعنصر أو أكثر من عناصر الثقافة المادية، كنقل الآلات التكنولوجية من
الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
ج. انتشار الأفكار: تحدث هذه العملية بدون
هجرة مباشرة، أو نقل للمعدات التكنولوجية، لكنها تحدث تغيرات ثقافية كبيرة في
المجتمع، مثل: انتشار أفكار حول الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وما تنادي
به الثورات من مبادئ اجتماعية.
مفاهيم
لها علاقة بالتغير الاجتماعي:
التغير الاجتماعي
مصطلح حديث نسبيًا، لكن ملاحظة التغير الاجتماعي والاهتمام به قديم قدم المجتمعات
الإنسانية.
توجد
العديد من المفاهيم التي تحمل معاني قريبة من معنى التغير الاجتماعي، مثل: (التقدم،
والتطور، والنمو، والتنمية). لكن بدأ العلماء المعاصرين يميزوا بين هذه المفاهيم،
سنتحدث عن كل مفهوم من هذه المفاهيم.
أولًا: التقدم:
التقدم: "هو حدوث
تغير في الطريق المرغوب فيه، والذي يحقق مزيدًا من الإشباع والرضا".
تعتبر فكرة التقدم
قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، فأول من استخدم مصطلح التقدم "لوكريتس"،
سنة (60ق.م)، لكن نظريات التقدم الاجتماعي أصبحت موضوعًا من موضوعات البحث
الاجتماعي في بداية القرن السابع عشر، فقد ذهب كلًا من (ديكارت، وبيكون) إلى أن
الإنسان يستطيع أن يحقق تقدمًا لا حد له عن طريق جهده وإرادته. ورأى "فونتينل"
أن تراكم المعرفة الإنسانية يساعد في التقدم المستمر للإنسان. وأكد "مونتسكيو"
على أهمية البيئة في إحداث التقدم الاجتماعي.
ارتبط مفهوم التقدم
ببعض نظريات القرن التاسع عشر، كنظرية "كوندرسيه" في مجال فلسفة
التاريخ، ونظرية "أوجست كونت" في مجال علم الاجتماع. أكدت هذه النظريات
على أن التاريخ يسير في خط تقدمي، وتفترض بأن التاريخ أوشك أن يبلغ ذروته بعد قيام
الثورة الصناعية والديمقراطية.
نتيجة
تطور العلوم الاجتماعية تعرضت هذه النظرة للتقدم إلى انتقادات نهاية القرن التاسع
عشر؛ بسبب القصور الذي يعاني منه هذا المفهوم، الذي يتمثل في استخدام مصطلح التقدم
الاجتماعي مرادفًا لمصطلح التغير الاجتماعي، وقد جاء هذا واضحًا في كتابات
كوندرسيه، وكونت، وغيرهما.
من التعريفات الحديثة
للتقدم:
v محمد الدقس: "حركة تسير نحو
الأهداف المنشودة والمقبولة... التي تأخذ شكلًا محددًا أو اتجاهًا خاصًا، ويتضمن
توجيهًا واعيًا مقصودًا لعملية التغيير".
v هوبهاوس: "نمو اجتماعي للجوانب
الكمية والكيفية في حياة الإنسان".
v كاريف: "تطور تدريجي يدل على نمو
المجتمع، وتصاحبه مؤشرات تدلل على مداه".
يتضح من التعريفات
السابقة أن التقدم عبارة عن مراحل ارتقائية، كل مرحلة أفضل من سابقتها، ويعني انتقال
المجتمع من مرحلة اجتماعية وتاريخية إلى مرحلة اجتماعية وتاريخية أفضل من حيث
الثقافة، والأفكار، وحجم السكانية، والإنتاج، والسيطرة على الطبيعة، والتحضر...
إلخ. بمعنى آخر، التقدم الاجتماعي يسير دائمًا في اتجاه واحد، إلى الأمام، وله هدف
محدد يسعى إلى تحقيقه وفق خطط محددة. بمعنى آخر، يعتبر التقدم فعل واعٍ ومخطط.
فكرة التقدم تتبدل
بتبدل الظروف، والزمان، والمكان. فكل تقدم وصلت إليه المجتمعات المعاصرة هو بفضل
المجتمعات السابقة؛ لأن التقدم لا يحدث فجأ، بل هو نتيجة تراكم خبرات سابقة. لكن التقدم
مسألة نسبية، فما يعتبر تقدمًا في هذا المجتمع قد يعتبر تخلفًا في مجتمع آخر. أي
يقاس تقدم المجتمع بحسب ثقافته، ومستواه الاقتصادي، ومستواه التعليمي، وتطوره التكنولوجي،
ونظامه السياسي، وسياسته السكانية، والبيئة المحيطة به. مثلًا: التقدم في أوربا في
القرن الثامن عشر كان يعني التحرر من تقاليد العصور الوسطى المتخلفة، كسيطرة
الكنسية على شؤون الحياة العامة، وسيادة الأنظمة الاستبدادية. في أمريكا عني
بالتقدم في القرن التاسع عشر الانطلاق نحو تعمير الأجزاء الوسطى والغربية من
القارة، والاستغلال الأمثل لموارد الطبيعة. في المجتمع العربي المعاصر يعني التقدم
التحرر من التبعية للغرب، والتخلص من الأنظمة السياسية الاستبدادية، وتعميم قيم
الديمقراطية وحرية التعبير، ومحاربة التخلف والجهل والمرض. والتقدم في المجتمع
الفلسطيني يعني التحرر من الاحتلال الصهيوني، وبناء مؤسسات المؤسسات الوطنية،
وبناء اقتصاد متحرر من التبعية للاحتلال الصهيوني، وتحرير الأسرى من السجون
الصهيونية.
تطور مفهوم التقدم
الاجتماعي في القرن التاسع عشر بجهود رواد علم الاجتماع الذين نظروا إلى التقدم
نظرة تفاؤلية، مثل: كوندرسيه، وكونت، وسان سيمون، وغيرهم. لكن أفكارهم لم تكن متطابقة
مع الواقع الاجتماعي، فقد بقيت مجرد فكرة إلى أن كتب "وليام أوجبرن" كتابع
بعنوان: "التغير الاجتماعي" سنة 1922م، حيث حلت فكرة التغير الاجتماعي
محل فكرة التقدم الاجتماعي. وهذا يدلل على اختلاف المفهومين. التقدم الاجتماعي يعني:
التحسن المستمر على الدوام نحو الأمام، ويسير في خط صعود. أما التغير الاجتماعي:
قد يكون تقدمًا أو تخلفًا.
بناءً على ما سبق، فإن
مصطلح التغير الاجتماعي أكثر علمية من مصطلح التقدم؛ لأنه يتوافق مع واقع
المجتمعات ما بين تقدم وتخلف، فالمجتمعات ليست دائمًا متقدمة، وليست دائمًا متخلفة،
فهي تنتقل من حال إلى آخر بحسب الظروف التي تمر بها.
ثانيًا: التطور:
يعرف التطور:
v "النمو البطيء المتدرج الذي يؤدي
إلى تحولات منتظمة ومتلاحقة، وتمر بمراحل مختلفة ترتبط فيها كل مرحلة بالتي
سبقتها".
v معجم علم الاجتماع: "عملية بموجبها
تحقق المجتمعات الإنسانية نموًا مستمرًا مرورًا بمراحل متلاحقة مترابطة".
التطور من المفاهيم
المتداولة في العلوم الطبيعية، يشير إلى التطورات التي تمر بها الكائنات الحية من
أشكالها البسيطة إلى أشكالها المعقدة، ويستخدم لوصف التحولات في الحجم والبناء.
وقد استعار علم الاجتماع مفهوم التطور من علم الاحياء، متأثرًا بنظرية "داروين"
عن تطور الكائنات الحية التي فصَّلها في كتابه "أصل الأنواع" الذي وضعه
سنة 1859م. ووظفه علماء الاجتماع في الدراسات الاجتماعية، حيث استخدمه "هربرت
سبنسر"؛ ليبين أن تطور المجتمع يسير على خطى تطور الكائنات الحية، فتحدث في
كتابه "أصول علم الاجتماع" عن المماثلة العضوية أو المماثلة البيولوجية بين
المجتمع البشري والكائنات الحية؛ لوصف التحولات التي تطرأ على المجتمعات البشرية، فشبه
المجتمع بالكائن الحي في نموه وتطوره، حيث أن الحياة الاجتماعية تتطور من الشكل
البسيط إلى الشكل المعقد كما تتطور الكائنات الحية، والحياة الاجتماعية تخضع لمبدأ
الصراع والبقاء للأقوى، كما هو الحال في الطبيعة بين الحيوانات. كما استخدم "إدوارد
تايلور" مفهوم التطور في كتابه "الثقافة البدائية".
انتقد مجموعة من
العلماء تشبيه التطور الاجتماعي بالتطور البيولوجي، من هذه الانتقادات:
v أوجبرن: بيَّن أن المحاولات المبذولة
للكشف عن قوانين الوراثة والتنوع في تطور النظم الاجتماعية، لم تسفر إلا عن قليل
من النتائج الحيوية والهامة.
v تشايلد: ميز بين التطور الاجتماعي
والتطور البيولوجي، مبينًا أن الإرث الاجتماعي الإنساني لا ينقل عن طريق الخلايا
المورثة التي نشأ عليها الإنسان، بل ينقل عن طريق التراث الذي لا يكتسبه إلا بعد
خروجه من رحم أمه، فالتغيرات الثقافية يمكن بدئها عمدًا، والتحكم فيها، ويمكن
زيادة سرعتها أو إبطاءها بإرادة واعية مدروسة من قبل منفذيها، وليس الاختراع طفرة
عرضية في البلازما الموروثة، بل هو ناتج عن خبرات متراكمة ورثها المخترع عن طريق
التراث.
v ستيوارد: فرَّق بين التطور الاجتماعي
والتطور البيولوجي، حيث بيَّن أن التطور البيولوجي يسير في خط مستقيم حتمي، أما التطور
الاجتماعي يسير في عدة خطوط حسب اختلاف عوامله. من هنا ظهرت نظرية "المتعدد
الخطوط" التي تشكل نظرية جديدة يسعى من خلالها العلماء إلى فهم تطور الثقافة
الإنسانية وفقًا لتأثير العوامل السياسية، والاقتصادية، فالعوامل المختلفة تؤدي
إلى اختلاف التطور.
يلاحظ أن علماء نظرية التطور
القدامى والمحدثين اتفقوا على حتمية تطور المجتمعات الإنسانية، وأن تطورها يشبه تطور
الكائنات الحية، لكن العلماء المحدثين رأوا أن العوامل المختلفة تؤدي إلى تغير
اتجاه التطور العام. بمعنى آخر مفهوم التطور عند المحدثين قريب من مفهوم التغير
الاجتماعي.
ثالثًا: النمو:
يشير مصطلح النمو إلى النضج
التدريجي، والمستمر للكائن الحي، وزيادة حجمه الكلي أو الجزئي عبر المراحل العمرية
المتتابعة، ويشير إلى التغير الكمي والنوعي. التغيرات الكمية، مثل: التغير في حجم
السكان، والكثافة السكانية، وأعداد المواليد والوفيات، ومعدلات الزواج والطلاق،
ومعدلات الدخل القومي، ومعدلات الإنتاج الزراعي والصناعي... إلخ. لذلك فإن مفهوم
النمو أكثر انتشارًا في الدراسات السكانية، والاقتصادية. يرتبط مفهوم النمو بمفهوم
التغير الاجتماعي من الجانب الكمي، فالتغيرات المشار لها سابقًا كلها تؤثر في
البناء الاجتماعي، والوظائف الاجتماعية.
يختلف مفهوم النمو عن مفهوم
التنمية؛ لأن النمو عملية تلقائية، أما التنمية هي عملية إدارية، ومقصودة، ومخططة،
وواعية.
نظريًا يقترب مفهوم
النمو من التطور، لكنه لا يتطابق معه. وقد استخدم مفهوم النمو في الدراسات الحديثة
بمعانٍ مختلفة، فيقال مجتمعات نامية، ومجتمعات أقل أو أكثر نموًا. فالنمو لا يشير
إلا لجزء يسير من التغير الذي هو بمعنى التقدم، مع المحافظة على جوهر البناء
العام، أما الجزء الأخر من التغير لا يشمله النمو؛ لأنه يشير إلى التخلف.
بين "هربرت سبنسر"
أن فكرة النمو في المجتمعات تشبه النمو لدى الكائنات الحية، فالتجمعات السكانية
يمكن زيادة عدد سكانها، أي زيادة حجمها، وكذلك تنمو أحجام الكائنات الحية خلال
فترة من الزمن، والنمو الاجتماعي يبقى مستمرًا إلى أن تنقسم المجتمعات أو يقضى
عليها.
وجه الاختلاف بين النمو الاجتماعي والتغير الاجتماعي:
1. يشير النمو إلى الزيادة الثابتة نسبيًا،
والمستمرة في جانب واحد من جوانب الحياة. أما التغير يشير إلى التحول في البناء
الاجتماعي، والنظام، والأدوار، والقيم، وقواعد الضبط الاجتماعي، وقد يكون هذا التحول
إيجابيًا أو سلبيًا.
2. يكون النمو تدريجيًا وبطيئًا، أما
التغير قد يكون كذلك، وقد يكون سريعًا، وقد يكون إلى الأمام أو إلى الخلف.
3. يسير النمو في خط مستقيم، بالتالي يمكن
التنبؤ به، أما التغير فلا يسير دائمًا إلى الأمام بالتالي يصعب التنبؤ به.
رابعًا: التنمية:
v التنمية: "هي الجهود التي تبذل
لأحداث سلسلة من التغييرات الوظيفية، والهيكلية اللازمة لنمو المجتمع، وذلك بزيادة
قدرة أفراده على استغلال الطاقة المتاحة لأقصى حد ممكن لتحقيق أكبر قدر من
الرفاهية والحرية لهؤلاء الأفراد بأسرع من معدل النمو الطبيعي".
v "التحريك العلمي المخطط للعمليات
الاجتماعية والاقتصادية من خلال أيديولوجية معينة، بغية الانتقال بالمجتمع من حالة
غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب فيها، متضمنة الوصول بالمجتمع إلى أعلى درجات
التقدم".
لا يمكن الفصل بين
التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية؛ نظرًا للترابط الوثيق بينهما.
اتجاهات تعريف التنمية الاجتماعية:
1. الاتجاه الرأسمالي: يعتبر
التنمية عبارة عن مراحل نمو تدريجية مستمرة، تتضمن إشباع حاجات الإنسان الاجتماعية
من خلال إصدار التشريعات، ووضع البرامج الاجتماعية، وتنفيذها عبر المؤسسات
الحكومية والأهلية. فهي بذلك تعني الرعاية الاجتماعية التي تتضمن جانبًا واحدًا من
جوانب الخدمات الاجتماعية.
2. الاتجاه الماركسي: يتبر
التنمية الاجتماعية عملية تغير اجتماعي، لكنه تغير لا يكون إلا بالثورة على النظام
الرأسمالي، وإقامة نظام اجتماعي جديد، يتبنى قيم حديثة، ويغير علاقات الإنتاج
لصالح طبقة البروليتاريا (العمال). فالتغير عند الماركسيين يتجه نحو البناء
التحتي؛ لإحداث التغير الاجتماعي المطلوب.
3. الاتجاه الاجتماعي: يمثله
المفكرون الاجتماعيون، الذين يعتبرون التنمية الاجتماعية هي تحقيق التوافق
الاجتماعي لأفراد المجتمع، ويقصد بهذا التوافق إشباع حاجات الإنسان النفسية،
والاجتماعية، والبيولوجية.
يرتبط مفهوم التنمية
بمفهوم التحديث، ويعرف: "التحول من نمط المجتمع الذي يعتمد على تكنولوجيا
تقليدية، وعلاقات تقليدية، ونظام سياسي تقليدي، إلى نمط متطور تكنولوجيًا،
واقتصاديًا، وسياسيًا".
تفهم عملية التحديث من
خلال المقارنة بين المجتمعات التقليدية، والمجتمعات الغربية التي قطعت شوطًا كبيرًا
في التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والاستقرار السياسي.
يتضح من العرض السابق
متانة العلاقة بين مفاهيم التنمية، والتحديث، والتغير الاجتماعي. فالتحديث، والتنمية
يسهمان في إحداث التغير الاجتماعي، لكنهما ليسا بديلين عنه؛ لأنهما يعبران عن حالة
خاصة بتحول المجتمعات التقليدية إلى مجتمعات حديثة، أما التغير الاجتماعي أشمل من التنمية.
لكن مفهوم التنمية الاجتماعية أقرب إلى مفهوم التغير الاجتماعي من مفاهيم: التقدم،
والتطور، والنمو.
عوامل
التغير الاجتماعي:
أولًا: العوامل الخارجية:
يقصد بالعوامل
الخارجية: العوامل التي لا دخل للإنسان فيها، والتي تحدث تغيرًا تلقائيًا في
المجتمع، تشمل ثلاثة عوامل، هي: البيئة، والسكان، والثقافة. فيما يلي توضيحها:
1.
العوامل البيئية (الفيزيقية):
توجد علاقة بين
الإنسان والبيئة الفيزيقية، حيث يتأثر الإنسان بالبيئة المحيطة به، كما تؤثر البيئة
في الإنسان، وفي البناء الاجتماعي، وفي نمط الحياة. فالناس يكيفوا سلوكهم وحياتهم تبعًا
لتقلبات الطقس. والبيئة تحدد طبيعة النشاط الاقتصادي في المجتمع سواء كان زراعيًا،
رعويًا، صيدًا، صناعة، تجارة. وقد اتضح ذلك جليًا في الحضارات القديمة، فظهر الجمع
والالتقاط في المناطق الخصبة، والرعي في المناطق الصحراوية، والتجارة في المدن
الساحلية.
وعليه، فإن البيئة
الفيزيقية تترك أثرها على مستوى التغير الاجتماعي، وطبيعته في المجتمع. لكن
العوامل الفيزيقية ليست هي العامل الوحيد المسؤول عن عملية التغير الاجتماعي، بل
تشاركها عوامل أخرى.
تأثير العوامل
الفيزيقية في التغير الاجتماعي قد يؤدي إلى تغير إيجابي كما حدث في دول الخليج بعد
اكتشاف البترول، فقد نقلها من مستوى اقتصادي تقليدي متخلف إلى مستوى اقتصادي متقدم.
وقد تؤدي العوامل البيئية الفيزيقية إلى تغير سلبي، كما حالة الفيضانات، والزلازل،
والبراكين. فهذه قد تؤدي إلى انهيار مجتمعات بأكملها.
من العوامل الفيزيقية
التي تسهم في عملية التغير الاجتماعي:
§
البترول.
§
المعادن.
§
الغابات.
§
الطاقة
الشمسية.
§
الفيضانات.
§
الزلازل.
§
البراكين.
§
الأعاصير.
§
البحار.
§
الأنهار.
يقصد بالعوامل
الديموغرافية: كل ما يتعلق بالسكان من حيث حجم السكان، والتكوين السكاني، والكثافة
السكانية، والنمو السكاني، والسياسة السكانية، والخصوبة، والمواليد، والوفيات،
والزواج، والطلاق، والهجرة... إلخ.
تعتبر الظاهرة
السكانية ظاهرة ديناميكية، وليست إستاتيكية. بالتالي فإن عدد السكان في أي مجتمع من
المجتمعات معرض للزيادة أو النقصان؛ نتيجة عوامل طبيعية أو عوامل بيئية. عوامل الزيادة
السكانية، هي: (المواليد، والهجرة). وعوامل نقصان السكان، هي: (الحروب، والهجرة،
والوفيات).
منذ بداية البشرية حتى
مطلع القرن الخامس عشر كان عدد سكان العالم يتزايد ببطء شديد، تماشيًا مع حركة نمو
المجتمعات البطيئة، لكن مع مطلع القرن الخامس عشر كانت بداية التغيرات السكانية
السريعة. وقد مر النمو السكاني عبر تاريخ البشرية في ثلاث مراحل رئيسية، حيث شهدت كل
مرحلة تغيرات سكانية، وهي انعكاس لحالة التغير الاجتماعي، وتطور النشاط الاقتصادي.
هذه المراحل هي: الجمع والالتقاط، والزراعة، والصناعة. المرحلة الأولى: شهدت ارتفاعًا
في معدلات الوفيات، لاسيما في صفوف الأطفال؛ بسبب انتشار المجاعة، والأمراض، وهجوم
الحيوانات المفترسة، والكوارث الطبيعية. قابلها ارتفاع في معدلات المواليد؛ ليحافظ
على التوزان السكاني، وحماية الإنسان من الانقراض. في المرحلة الثانية وطدت
علاقات الزواج، ولعبت المرأة دورًا بارزًا في النشاط الاقتصادي (الزراعة، والرعي)،
وزادت معدلات الخصوبة، وانخفضت معدلات الوفيات؛ بسبب تراجع نسبة الجوع، وتحسن
الأحوال المعيشية مقارنة بالمرحلة الأولى، وارتفع عدد السكان ما بين (3-5%) سنويًا.
حيث كان يعيش في العالم سنة خمسة آلاف قبل الميلاد حوالي خمس وعشرين إلى ثلاثين
مليون نسمة. المرحلة الثالثة: شهدت توازنًا في معدلات المواليد والوفيات المرتفعة.
ومع تطور الثورة الصناعية شهدت تحولات سكانية كبيرة، حيث أصبح النظام الرأسمالي هو
أساس الاقتصاد، فترتب على ذلك تدني معدلات الوفيات، وارتفاع معدلات المواليد،
الأمر الذي ساهم في حدوث الانفجار السكاني في العالم. وقد أشارت تقديرات الأمم
المتحدة أن سكان الدول النامية وصل سنة1990م حوالي مليار نسمة. بمعنى آخر، الدول النامية
تشهد ارتفاعًا في معدلات النمو السكاني، لكن بدرجات متفاوتة بين الدول. وبينت
تقديرات الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم تخطى حاجز السبعة مليار نسمة، حيث تأتي
آسيا في مقدمة القارات من حيث الكثافة السكانية، إذ تحتل (59.9%) من سكان العالم،
يأتي بعدها أفريقيا بنسبة (15.7%)، ثم أوربا بنسبة (10.3%)، ثم أمريكا الشمالية
بنسبة (4.9%)، ثم أمريكا اللاتينية بنسبة (8.6%). وقد بدأ العالم يشهد نموًا
متزايدًا في عدد السكان منذ عام (1350م)، أي مع نهاية الطاعون الأسود، الذي اجتاح
أوربا في القرن الرابع عشر، تحديدًا في الفترة بين عامي (1347-1352م)، حيث تسبب في
موت ثلث سكان أوربا، في هذه الفترة أيضًا انتشرت الأمراض والأوبئة في آسيا والشرق
الأدنى، التي أزهقت الكثير من الأرواح فأثرت على التركيب الديمغرافي في المجتمعات.
يرتبط النمو السكاني
بعمليتي التحضر، والتصنيع. فقد انطلقت الثورة الصناعية في انجلترا مع اكتشاف الآلة
البخارية في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر، ثم انتقلت إلى أوربا الغربية، ومنها
إلى جميع دول العالم. ففي منتصف القرن الثامن عشر انطلقت الثورة الزراعية التي
حسَّنت المستوى المعيشي لسكان الريف، حيث زاد اعتمادهم على الآلات الزراعية
المتطورة التي وفرت عليهم الجهد والوقت، مما يعني ضعف اعتمادهم على الإنسان. في
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، شهدت الدول الغربية تكدس رأس المال
في أيدي فئة قليلة من الأفراد، ممثلة في الطبقة الرأسمالية، واستغلالهم لفئة كبيرة
ممثلة في طبقة العمال، فأوجد فجوة عميقة بين الطبقتين يصعب ردمها، فساهم ذلك في
ظهور الأيديولوجيا الاشتراكية التي ناهضت الرأسمالية، وطالبت بالدفاع عن حقوق
ومطالب طبقة البروليتاريا.
التطور الصناعي
والتكنولوجي الهائل، والنمو السكاني المتزايد تركت بصماتها الواضحة في كافة مجالات
الحياة الاجتماعية، حيث صاحبها ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية،
مثل: الهجرة، وارتفاع معدلات البطالة، والفقر، والأمية، والجريمة، وعمالة الأطفال،
وتدني دخل الفرد، وانتشار ثقافة الاستهلاك، وحلول
الآلة محل الإنسان... إلخ.
3.
العوامل الثقافية:
تعتبر الثقافة من
العوامل المؤثرة في عملية التغير الاجتماعي، خاصة أننا نعيش في عصر العولمة
الثقافية، حيث الانفتاح على ثقافات العالم. فالاتصال الثقافي يسهم في التغير
الاجتماعي. وليس ثمة خلاف على أن ثقافة العولمة هي ثقافة مادية استهلاكية بالدرجة
الأولى، تسعى لإحلال ثقافة التسلية محل ثقافة العقل. فالغرب لا يصدرون قيمًا اجتماعية
نافعة للمجتمعات الأخرى كالعدل، والحرية، والمساواة؛ لأن هذه المجتمعات من وجهة
نظرهم شعوب متخلفة لا تستطيع التعايش مع تلك القيم المتحضرة، فلم ترق بعد إلى سمو
هذه القيم! لكنهم جديرون، - من وجهة نظرهم -، بتحويلنا إلى قطعان من الشعوب
للتسمين، والتجارة، والربح، والاستهلاك دون أدنى احترام للثقافة المحلية التي تمتد
لآلاف السنين.
ثقافة العولمة رديف
الثقافة الغربية والأمريكية التي تهدف إلى جعل الثقافة الغربية والأمريكية ذات
طابع عالمي، بذلك تريد القضاء على الخصوصية الثقافية، والتبادل الثقافي، والتنوع
الحضاري بين الشعوب عن طريق أنماط السلوك، وطرق التفكير، والمنتجات الثقافية
(الأفلام، والمسلسلات، والأغاني)، وتسريحات الشعر، وتصميمات الملابس، وتوحيد القيم
حول الأسرة والمرأة والطفل، وتكريس النزعة الأنانية، ونشر الفاحشة، والرذيلة،
والانحلال الأخلاقي، والشذوذ الجنسي، وخدش الحياء. بكلمات عبد الإله بلقزيز
العولمة الثقافة هي: "اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر الثقافات".
العولمة الثقافية تتجه
نحو تقزيم العادات، والتقاليد، والقيم، مقابل ترويج عادات، وتقاليد، وقيم الغرب
الفردية الاستهلاكية على اعتبار أنها القاعدة الأساسية في تعاون الدول في ظل
العولمة. يدعم هذا القول الوثيقة التي صدرت عن قمة الاتحاد الأوربي سنة 2000م، تحت
عنوان: "الاستراتيجية المشتركة للاتحاد الأوربي في المتوسط"، التي هدفت
إلى تغيير بعض القيم الدينية في الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، بحيث
تتلاءم مع القيم الأوربية.
تنتهي العولمة
الثقافية لممارسة ما يشبه العدوان الممنهج على ثقافات الشعوب، وقيمها، وتراثها. فيكون
على البلدان جميعها ارتداء الثوب أو اللون الواحد، وتأكل في الصحن الواحد، وتقرأ
الكتاب الواحد، ويصاغ لها طموحات واحدة، وأذواق واحدة، وأفكار واحدة، ونمط حياة
واحد.
تعميم ثقافة الاستهلاك
يعتبر واحدًا من آليات الهيمنة الغربية المفروضة على الشعوب والأمم التقليدية. وقد
تشكلت مؤسسات خاصة لهذا الغرض حتى تضمن الفئات الرأسمالية تصريف منتجاتها وتوزيعها
عالميا على أوسع نطاق. هذا وقد لعبت الشركات متعددة الجنسيات دورًا مؤثرًا في ذلك،
واهتمت بإنتاج رموز وبنود ثقافة الاستهلاك لتتكامل مع السلع المادية المنتجة.
على صعيد ثقافة
الاستهلاك: نسترشد ببعض الإحصائيات عن نساء السعودية. حيث أشارت الإحصائيات سنة
1995م إلى الحقائق التالية:
v استهلكن (538) طنًا من أحمر الشفاه.
v استهلكن (43) طنًا من طلاء الأظافر.
v استهلكن (41) طنًا من مزيلات الطلاء.
v استهلكن (232) طنًا من مسحوق تجميل
العيون.
v استهلكن (445) طنًا من مواد صبغة الشعر.
v أنفقن (1200-1500) مليون ريال سعودي على
العطور.
v
(4400)
امرأة مصاريفهن خلال الصيف فقط (110) ملايين ريال فساتين الحفلات، وثمانية آلاف
ريال متوسط كلفة الفستان.
v ما تنفقه المرأة الواحدة على كل زينتها
خلال الحفلة (25) ألف ريال.
ثانيًا: العوامل الداخلية:
يقصد بالعوامل
الداخلية: العوامل النابعة من داخل المجتمع، والتي لها قدر من الاستقلال النسبي في
الطريقة التي تؤثر فيها في مجرى التغير الاجتماعي، من بين هذه العوامل: النظام
السياسي.
لم يكن النظام السياسي
يلعب دورًا مهمًا في المجتمعات البدائية البسيطة (الزراعية، والرعوية)، حيث لم تكن
تنعم هذه المجتمعات بدرجة كبيرة من الاستقرار الاجتماعي والسياسي التي تمكن النظام
السياسي من التأثير والتغير في المجتمع. وقد كانت هذه المجتمعات إستاتيكية، أي
بطيئة التغير. وكان لظهور الدولة الحديثة دور في التغير الاجتماعي. حيث يلعب
النظام السياسي دورًا مهمًا في عملية التغير من خلال تنظيم العلاقات الخارجية،
وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
فكلما كان النظام السياسي مستقرًا حقق درجة كبيرة من الشرعية، وتتحقق هذه الشرعية
من خلال المشاركة السياسية.
ثالثًا: العوامل التكنولوجية:
ساهم التقدم
التكنولوجي، والاختراعات، والاكتشافات العلمية دورًا كبيرًا في تغير المجتمعات.
على الرغم مما قدمته
التكنولوجيا من خدمات جليلة للمجتمعات الإنسانية، إلا أن لها جانبًا سلبيًا، فهي أسهمت
في ظهور مشكلات اجتماعية واقتصادية جديدة، أو زادت من انتشار مشكلات اجتماعية واقتصادية
قائمة كالسرقة، والبطالة، والتسول، والبغاء، والانحراف، والتزوير، والرشوة... إلخ.
هنا تبرز أهمية التخطيط الاجتماعي، وتنظيم المجتمع لإحداث التغيرات الاجتماعية
المقصودة لمواجهة المشكلات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية.
لقد اعتبر "وليام
أوجبرن" التكنولوجيا من عوامل التغير الاجتماعي، والتخلف الثقافي في
المجتمعات الحديثة. ورأى "شنيدر" أن التغيرات في المجتمعات ليس كلها
ناتجة عن العمل أو سياسة الدولة، لكنها نتيجة التغيرات التكنولوجية، فباستمرار
التغير التكنولوجي يستمر التغير الاجتماعي. ورأى "لوبير" أن التكنولوجيا
لا يمكن أن تعمل أو تتغير بدون التنظيم، والفكر.
العوامل المؤدية إلى التغير
الاجتماعي هي عوامل خارجة عن التكنولوجيا، فبقدر ما تساعد كفاءة التكنولوجيا في
تحرير أفراد المجتمع، بتقليل الحاجة إلى العمل المستمر لكي يعيشوا، بقدر ما تكون
فعالية التنظيم والرؤية الواضحة للمجتمع. فالكفاءة التكنولوجية تؤدي إلى ظهور
التنظيم الدقيق، والفكر الواضح. وعليه، إن التغير الاجتماعي يعتمد على تغيير
الأفكار الرئيسية للمجتمع، والتي يخرج منها أنظمة تنظم العلاقات بين الأفراد
والجماعات. والتقدم التكنولوجي ليس عاملًا وحيدًا لإحداث التغير الاجتماعي.
رابعًا: العوامل الفكرية والفلسفية:
يحدث التغير الاجتماعي
نتيجة أفكار متعددة، ينتج عنها استمرارية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد
والجماعات، كالفكر الماركسي ومدى تأثيره في البناء الاجتماعي الروسي، والفكر
الرأسمالي ومدى تأثيره في المجتمع الأمريكي والأوربي. فكل أيديولوجيا أو مذهب فلسفي
له أهداف وغايات، تشكل أساليب الفكر والسلوك، فتسهم في تغير المجتمع. أي تغير في
الأصول الفكرية يظهر أثرها في الواقع الاجتماعي، والتاريخ يشهد على كثير من
الأمثلة كالديانات السماوية، وحركات الإصلاح الديني، والحركات الاجتماعية،
والثورات السياسية.
يعتبر كل من أوجست
كونت، وماكس فيبر العوامل الفكرية من عوامل التغير الاجتماعي، فمن وجهة "فيبر"
تلعب العوامل الفكرية دورًا كبيرًا في إحداث التغير الاقتصادي الذي ينشأ عنه تغير
اجتماعي، وهذا ينشأ عنه تغير ثقافي. وقد أرجع "فيبر" ظهور النظام
الرأسمالي إلى النظام الأخلاقي عند البروتستانت الذين عرفوا بالمثابرة، والاجتهاد،
والسعي لكسب الرزق، والتوسع في التجارة.
يرى "ليونبرجر"
أن الإنسان يمر في عدة مراحل قبل أن يأخذ بالفكر الجديد:
1.
أول
سماع أو معرفة بالموضوع الجديد.
2.
جمع
المعلومات عن الموضوع الجديد؛ ليقيم مدى فائدته.
3.
اختبار
المعلومات المجمعة عن الموضوع الجديد، وتفسيرها وفق الظروف السائدة، ودراسة مدى
ملائمتها للأخذ بها.
4.
اختبار
الفكرة، وكيفية تطبيقها.
5.
التسليم
بالموضوع الجديد، اعتماده ليأخذ مكانه في النمط السائد.
الجدير بالذكر، هذه
المراحل الخمس لا تأتي دائمًا مرتبة، وقد يطرأ عليها تغيير بإضافة عناصر جديدة، أو
حذف بعضها، أو تداخل بعضها.
مراحل
التغير الاجتماعي والثقافي:
1) اختراع، أو اكتشاف، أو استعارة.
2) انتشار.
3) سماع، اهتمام، حاجة، كفاءة.
4) صراع.
5) توافق، قبول، تكامل، تجديد.
6) تغير ثقافي مادي أو غير مادي.
خصائص
التغير الاجتماعي المعاصر:
1)
السرعة.
2)
الترابط
زمانًا ومكانًا، بحيث يكون التغير متتابعًا، وليس متقطعًا.
3)
الوسائل
التكنولوجية تكسب الفرد خبرات معرفية جديدة.
4)
تؤثر
التغيرات على أسلوب حياة الفرد الشخصية التي قد تتوافق مع السياق الاجتماعي العام،
أو لا تتوافق.
5)
تدخل
النظم السياسية لإحداث التغير في المجتمع.
كيف
يُدرَس التغير الاجتماعي؟
سواء كان التغير
الاجتماعي مخططًا له أو غير مخطط له، وسواء كان كميًا أو نوعيًا، فإنه يمكن دراسته
وفق ستة مكونات متصلة ببعضها، هي:
1. نوع التغير الاجتماعي وهويته:
يشير إلى الظواهر التي تتعرض للتغير كالسلوك، والممارسات اليومية، والاتجاهات،
وصور التفاعل الاجتماعي.
2. مستوى التغير الاجتماعي:
يشير إلى الموضع الذي يحدث فيه التغير الاجتماعي، ومستوياته، قد يكون على مستوى
الفرد، أو الجماعة، أو التنظيم الاجتماعي، أو النظم الاجتماعية، أو المجتمع برمته.
3. زمن التغير الاجتماعي:
يشير إلى المدة الزمنية التي يقع فيها التغير الاجتماعي، فقد يكون التغير قصير
المدى، أو طويل المدى.
4. وجهة التغير الاجتماعي:
تشير إلى المسلك الذي يسير فيه التغير الاجتماعي، فقد يكون تطوريًا، أو طفرات، أو
تذبذب.
5. حجم التغير الاجتماعي:
يشير إلى مقدار التغير الاجتماعي، قد يكون في شكل زيادة بسيطة لعناصر جديدة، وقد
يكون تغيرًا هامشيًا، وقد يكون تغيرًا شاملًا وثوريًا.
6. معدل التغير الاجتماعي:
يشير إلى سرعة وبطء التغير الاجتماعي، وقد يكون التغير مستمرًا أو متقطعًا، أو
يكون منظمًا أو فوضويًا.
هذه المكونات الستة تساعد في دراسة التغير الاجتماعي من جوانبه المختلفة، وتتيح الفرصة للمقارنة بين أشكال التغير في المجتمعات والثقافات المختلفة، وتعطي مؤشرات واقعية لقياس التغير الاجتماعي.
مراجع الفصل:
1.
بسام
محمد أبو عليان، الانحراف الاجتماعي والجريمة، ط3، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي،
2016.
2.
بسام
محمد أبو عليان، محاضرات في علم اجتماع السكان، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2017.
3.
دلال
ملحس استيتية، التغير الاجتماعي والثقافي، ط2، عمان، دار وائل للنشر، 2008.
4.
سيف
الإسلام علي مطر، التغير الاجتماعي – دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية، ط2،
المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، 1988.
5.
قسم
علم الاجتماع، البناء والتغير الاجتماعي، جامعة الأقصى، خانيونس، العام الدراسي
2006-2007.
6. مجهول المؤلف، في نظرية التطور الاجتماعي، ترجمة: واسيني الأعرج، ط1،
دمشق، دار دمشق، 1982.
7. محمد الدقس، التغير الاجتماعي بين
النظرية والتطبيق، ط2، عمان، مكتبة مجدلاوي، 1996.
االمرجع| بسام محمد أبو عليان، التغير الاجتماعي، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2021.
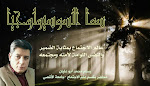
تعليقات
إرسال تعليق