نشأة المدينة وتطورها:
تعتبر المجتمعات البدائية هي أصل المجتمعات المتحضرة، حيث
كانت تتكون من عشرات أو مئات الناس، وربما الآلاف في بعض الحالات، جمعتهم علاقات
القرابة في مرحلة الاستقرار. أغلبهم من المهاجرين الذين أتوا من أماكن أخرى، ومارسوا
مهنة الزراعة. كان ذلك في العصر الحجري الوسيط، ذروة اختراعات آلات العمل الزراعي التي
أعانتهم على الزراعة، فساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي الذي فاض عن حاجة الناس
الأساسية، فكان لابد من تسويق الفائض إلى القرى المجاورة بإتباع نظام المقايضة. فيما
بعد اشتغل بالمقايضة كل من لا يعمل في الزراعة، وقد تطور الأمر بعد ذلك فظهرت طبقة
التجار، وأصحاب الحرف. ثم توالت سلسلة تغير وتطور المجتمعات البشرية حتى وصلت إلى
حياة المدينة. بمعنى آخر، يمكن القول: أن التجمعات الإنسانية الأولى كانت من
الأسر، ثم العشائر، ثم القبائل، ثم القرى مع اكتشاف الزراعة والاستئناس بالحيوان، ثم
المدن مع ظهور التجارة والصناعات الخفيفة، ثم المدينة المعقدة.
إن انتقال المجتمعات من مرحلة حضارية إلى أخرى لم يكن
انتقالًا كليًا، أي ليس انتقالًا يقطع صلته تمامًا بالمرحلة التي سبقتها؛ بدليل
استمرار المجتمع الريفي إلى جانب المجتمع الحضري. فلم تنفِ المدينة القرية أو
العكس.
أهمية
دراسة المدن:
1)
زيادة
نفوذ المدن مقارنة بالريف؛ بسبب ارتفاع نسبة التعليم، وكبر المساحة الجغرافية،
وتنوع خدماتها.
2)
تعد
المدينة من ضروريات الحياة الاقتصادية للريف، فكل منتجات الريف الفائضة عن الحاجة تصب
في المدينة.
3)
ارتفاع
عدد سكان المدن، وتناقص في عدد سكان الريف.
4)
بعد
المسافة بين الريف والحضر يؤدي على هجرة الريفيين إلى المدن.
5)
ارتباط
المدن بالتصنيع، والتجارة.
6)
المدينة
هي مركز الاتصال والانفتاح على الآخر.
ملامح
المدن القديمة:
تعد المدن المصرية الفرعونية من أسبق المدن في العالم ظهورًا.
حيث كانت تتمتع المدينة باستقلال ذاتي، ويحكمها مجلس العشيرة، وسيطر على بعضها
الطابع الديني، مثل مدينة آمون.
في اليونان ظهرت المدن المستقلة كدولة قائمة بذاتها، بلغ عدد
سكان بعضها في القرن الخامس قبل الميلاد (150.000) نسمة. عرفت الديمقراطية في
علاقة الحكام بالمحكومين، ومجدت الفنون. قسم سكانها إلى أربع طبقات اجتماعية، هي:
1)
مواطنون:
يشاركون في السياسة والوظائف العامة.
2)
أحرار:
يعملون بحرية، لكن ليس لهم شرف المواطنة.
3)
أجانب
مستوطنون: هؤلاء موضع حذر وريبة.
4)
عبيد.
في العصر الروماني قامت مدن كثيرة لأسباب سياسية واقتصادية، من
هذه المدن: صور ازدهرت فيها الصناعة، وتدمر وجرش ومرسيليا نشطت فيها التجارة، ومن
المدن السياسية: الإسكندرية، ودمشق، وبيروت.
قسمت المدينة الرومانية إلى أحياء، وتوجد فيها مؤسسات حكومية،
وحلقات للتعليم، وأسواق، ودور عبادة، ومراكز للصناعة الأولية، خطط لتتسع المدينة
(6000) أسرة، وأن تكون قريبة من الطرق البرية والنهرية.
ملامح مدن العصور
الوسطى:
في العصور الوسطى انطفأ ضوء الحضارة الأوربية، وسطع نجم
الحضارة الإسلامية. فقد تميزت الحضارة الإسلامية بظاهرة التخصص، فكان لكل مدينة
طابعها الخاص.
v مدن دينية: مكة، والمدينة، والقدس.
v مدن سياسية: بغداد، ودمشق.
v مدن ثقافية: الكوفة، والبصرة.
معظم مدن أوربا التي ازدهرت أواخر العصور الوسطى هي مدن
ساحلية، أما المدن الداخلية بقيت على حالتها القديمة، وقل عدد سكانها، وارتفع عدد
سكان المدن الحديثة.
أسباب
تطور المدن في أواخر العصور الوسطى:
v تحسن وسائل النقل.
v انتشار المصانع اليدوية الكبيرة.
v زيادة الإنتاج.
v اتساع المنافسة بين الأسواق.
v زيادة الطلب على الأيدي العاملة.
v ظهور طبقة برجوازية من التجار، التي شكلت خطرًا
على طبقة الأشراف.
v انهيار النظام الإقطاعي، وظهور النظام الصناعي.
المدن
الحديثة:
قامت المدينة الأولى على أكتاف طبقة التجار، وأصحاب الحرف
الصغيرة. مع الثورة الصناعية تغير وسائل الصناعة، فتحولت من العمل اليدوي إلى العمل
الآلي، ومن العمل في البيوت والورش الصغيرة إلى العمل في المصانع. فصاحب ذلك
تغيرات اقتصادية كبيرة، وتغيرات في نمط العيش.
في السنة الأولى للثورة الصناعية ظهرت ثلاثة أنواع من المدن،
هي:
1)
مدن
المواد الأولية: تنتج الفحم، والحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والزنك، والخشب
بكميات كبيرة تقابل حاجات الصناعة.
2)
مدن
المواد المصنعة: تحول المواد الخام إلى سلع مصنعة.
3)
مدن
الاستيراد والتصدير: ظهرت مع ظهور الموانئ التي تقوم بمهمة استقبال وإرسال السلع.
التقسيم السابق لا يعني أن كل مدينة تخصصت في مهمة واحدة
فقط، فقد ظهرت مدن تخصصت في الثلاثة مجالات، تستخرج المواد الخام، وتصنعها، وتصدرها.
مثل: لندن، وباريس، وليفربول، وهامبورغ.
مع زيادة إنتاج السوق الأوربية تسابقت الدول الأوربية للبحث
عن سوق خارجية تستورد منها المواد الخام، وتصدر لها فائض الإنتاج. أحيانًا يكون
ذلك بالقوة العسكرية، أو الاتفاقيات الدولية، أو الاحتلال. من هذه المدن التي كانت
سوقًا للمنتج الأوربي: تونس، الرباط، الجزائر، شنغهاي، سنغافورة... إلخ.
آثار
الثورة الصناعية على المدن الأوربية:
1)
زيادة
عدد السكان في المدن.
2)
زيادة
عدد المدن الكبرى.
3)
ارتفاع
درجة التحضر.
4)
زيادة
وتحسن طرق المواصلات والاتصال.
مصادر
نمو المدن الحديثة:
1)
زيادة
عدد المواليد وتدني عدد الوفيات؛ بسبب تحسن الخدمات الصحية.
2)
الهجرة
من الريف إلى الحضر بحثًا عن فرص عمل.
3)
الهجرة
الخارجية؛ نتيجة تطور أساليب التعاون والاتفاقيات الدولية.
مراحل
تطور المدينة الحديثة:
1.
مرحلة
ما قبل الصناعة: مرت بها أوربا الغربية وأمريكا في القرن الثامن عشر. كان أساس
المدينة الحصن، أو السوق، أو الميناء. الصناعة فيها يدوية، تعتمد على المواد الخام
الزراعية.
2.
مرحلة
الصناعة: مرت بها أوربا الغربية وأمريكا في القرن التاسع عشر. ظهرت مع ظهور الآلة
البخارية، اعتمدت فيها الصناعة على طاقة الفحم والكهرباء، وانتقلت الصناعة من
البيوت والأكواخ إلى المصانع.
3.
المتروبوليتان
(المدن الكبرى): بدأت مع القرن العشرين. تميزت باتساع الصناعة، وزيادة استعمال
الكهرباء، وتطور وسائل المواصلات مع ظهور السيارة، وتطول الاتصالات مع اكتشاف الهاتف.
المرجع: بسام أبو عليان، علم الاجتماع الحضري، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2020.
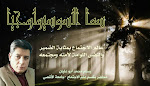

تعليقات
إرسال تعليق