 |
| د. بسام أبو عليان محاضر بقسم الاجتماع ـ جامعة الأقصى |
يعتبر العنف بكافة أشكاله ظاهرة قديمة قدم المجتمعات البشرية،
فقد رافق الإنسان مذ وجد على الأرض. بل القرآن الكريم سجل تعجب الملائكة عندما
أخبرهم الله تعالى أنه سيجعل الإنسان خليفة له على الأرض. سبب هذا التعجب الملائكي: ما
نسب للإنسان من الإفساد، وسفك الدماء مقارنة بحالهم التي هي عبادة، وتسبيح، وتقديس
دائم لله تعالى. {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ} [البقرة:30]. وقد ذكر القرآن الكريم عدة مشاهد
للعنف، منها: حادثة مقتل هابيل على يد شقيقه قابيل، وتآمر
أخوة يوسف عليه السلام؛ لقتله، ثم عدلوا عن ذلك، واستقر أمرهم على إلقائه في البئر، وتعنيف
فرعون لقومه، وتعنيف قريش لرسول الله ﷺ والصحابة رضي الله عنهم. إذن
للعنف قدم راسخة في كل المجتمعات على مر العصور. بل يعد علامة بارزة في واقعنا
المعاصر، فلا تكاد تمر لحظة إلا ويمارس فيها سلوك عنفي في بقعة من الأرض.
العنف في أبسط معانيه: "هو سلوك عدواني موجه ضد الآخرين بهدف الإيذاء أو
السيطرة".
للعنف صور عديدة: قد يكون جسديًا، أو جنسيًا، أو نفسيًا، أو صحيًا، أو أسريًا، أو اجتماعيًا، أو اقتصاديًا، أو سياسيًا، أو إعلاميًا. وقد يشمل أكثر من صورة في آن واحد.
وتعدد مجالات العنف، فقد يخص شريحة اجتماعية معينة، كالأطفال، النساء، المعاقين، طلبة المدارس، العمال، المرضى، الأطباء، الممرضين... إلخ. في هذه المقالة سأتحدث عن (تعنيف المسنين)، إذ يعتبر المسنون من الفئات الاجتماعية الضعيفة والمهمشة في المجتمع، والأكثر عرضة للعنف، إلى جانب الأطفال، والنساء. رغم ذلك، فإن المكتبة الفلسطينية تعاني من شح الدراسات
حول هذا الموضوع؛ لأن الحديث عن تعنيف المسنين، وصور التعنيف التي يتعرضون لها، أو كشف
هوية المعِّنف من الأمور المُتَساهَل بها، فغالبًا يتم التستر عليها من جانب المعنِّف، أو لا يفصح عنها المعنَّف، مما يعني تمادي المعنِّف في عنفه دون أي رادع ديني، أو
أخلاقي، أو مجتمعي، أو قانوني. لكن من خلال الملاحظات والشواهد الاجتماعية قد تعددت
مصادر تعنيف المسنين قد يكون الأسرة والأقارب، الجيران، العيادات الصحية الحكومية
تحديدًا، المؤسسات الاجتماعية...إلخ.
حتى وقت قريب كان المسنون يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية، ويعتبرون أحد أطراف الضبط الاجتماعي غير الرسمي؛ لما يتمتعون به من تقدير، واحترام، وهيبة، وسلطة اجتماعية، وخبرة حياتية في التعامل مع مختلف المواقف الاجتماعية. لكن
مع التغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة وما رافقها من ظواهر سلبية قد تراجعت مكانتهم، وقلت
هيبتهم، وتدنى احترامهم، وضعفت سلطتهم. فاجتمع هذا التردي الأخلاقي، والقيمي، والاجتماعي مع خصائص مرحلة الشيخوخة
البيولوجية، والنفسية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية التي يغلب عليها الهزال
الجسدي، وضعف القدرات العقلية، وسوء التكيف الاجتماعي، ونقص الدافعية، وتدني مصدر الدخل
إن لم يكن فقدانه. فشجع ذلك كله على ممارسة العنف ضد المسنين، وقد تعددت وتنوعت صوره. فتارة
يكون جسديًا كالضرب، أو جنسيًا كالتحرش، أو نفسيًا ولفظيًا كالرفض، والهجر، والإهمال،
والتحقير، والإهانة، والحرمان، والسخرية، والألفاظ الجارحة. أو صحيًا كالتجويع أو عدم
توفير الطعام الصحي اللازم، والتلكؤ في إرساله إلى الطبيب عند المرض، وعدم توفير
الأدوية المطلوبة، وإهمال نظافة جسده وهندامه. أو اجتماعيًا كحرمانه من المشاركة
في المناسبات الاجتماعية، وفرض العزلة الاجتماعية أو الانسحاب الاجتماعي من تلقاء
نفسه، والطرد من البيت، وإجباره على الإقامة في دار الرعاية، ومنعه من الزواج إن
رغب في ذلك. أو اقتصاديًا كعدم توفير وإشباع حاجاته الأساسية، وسرقة أمواله،
وحرمانه من حرية التصرف في أمواله وممتلكاته، وسوء استخدام ممتلكاته، والتزوير في
معاملاته المالية وأملاكه.
كل صور العنف السابقة تنعكس سلبًا على نفسية المسن، فبعدما كان يحتل موقعًا اجتماعيًا مهمًا في الأسرة أصبح يعامل معاملة مذلة مهينة. بعد أن
كان آمرًا ناهيًا في البيت أصبح لا يؤخذ برأيه، وإن أفصح عنه لا يحترم. بعد أن كان
محط تقدير واعتزاز أصبح معرضًا للسخرية، والاستهزاء، والشتيمة، والغمز، واللمز.
لذلك كان لابد من توعية أسرة المسن لتوفير سبل الحماية اللازمة له حفاظًا على
سلامته الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والاقتصادية.
أختم بآداب التعامل مع المسنين، ويمكن إيجازها في النقاط الآتية:
بداية نذكر بحديث رسول الله ﷺ: "ليسَ منَّا منْ لمْ يرحمْ صغيرَنا، ويوقرْ كبيرَنا".
أختم بآداب التعامل مع المسنين، ويمكن إيجازها في النقاط الآتية:
بداية نذكر بحديث رسول الله ﷺ: "ليسَ منَّا منْ لمْ يرحمْ صغيرَنا، ويوقرْ كبيرَنا".
- احترم المسن ووقره، من خلال مبادرته بالتحية، والمصافحة، والسؤال عنه، والمعاملة الطيبة، والحديث الحسن، ومناداته بأحب الأسماء إليه، والاسترشاد برأيه والاستفادة من خبراته.
- عامل المسن باللين، والرحمة، والصبر؛ لأنه معرض للنسيان، أو اللامبالاة، وبطئ الحركة.
- قدَّم المسن في كل شيء، في الدخول والخروج، والمجلس، والحديث، والطعام، والشراب، ركوب وسيلة المواصلات... إلخ.
- اسأل المسن عما يرغب، وعدد له الخيارات، ولا تفرض عليه نظامًا محددًا؛ ليؤكد استقلاليته، ويعزز ثقته في نفسه، ويكون إنسانًا إيجابيًا وفاعلًا.
- لا تقاطع المسن أثناء حديثه، لاسيما عندما يذكر أحداثًا من ماضيه، والتي ربما يكررها أكثر من مرة في المجلس الواحد، أو على مسمع نفس الشخص.
- شجِّع المسن على المشاركة في المناسبات الاجتماعية؛ لئلا يكون فريسة سهلة للانطواء والعزلة الاجتماعية، وما يترتب عليها من علل نفسية، واجتماعية، وجسدية.
- احذر من معاملة المسن بشفقة، أو النظر له بنظرة عجز، فهذا يؤديه نفسيًا.
- أشغل وقت فراغ المسن بالأعمال المفيدة التي يحبها، وامنحه الوقت الكافي لإنجازها.
- بيِّن فضل المسن على أسرته، أو مؤسسته إن كان موظفًا، أو على مجتمعه عمومًا.
- اهتم بنظافة المسن الشخصية.
- اهتم بغذاء المسن، والمراجعة الدورية عند الطبيب، والالتزام بتناول الأدوية، ويقع على عاتق المؤسسات الرسمية والأهلية توفير علاجاتهم مجانًا أو بسعر رمزي، وتأهيله طبيًا.
- حمايته من التعرض للإصابات، والحوادث.
- تشجيعه على ممارسة الأنشطة الرياضية الخفيفة التي تناسبه.
- مساعدته على التخلص من العادات السيئة كالإسراف في التدخين وتناول الأدوية دون استشارة الطبيب المختص.
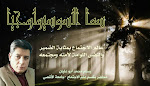
تعليقات
إرسال تعليق